الكردُ وجوداً ونشوءاً
صون الكردِ لوجودِهم بطابعِه الثقافيّ، يتأتى من قوةِ الثقافةِ التاريخيةِ التي يرتكزون إليها...
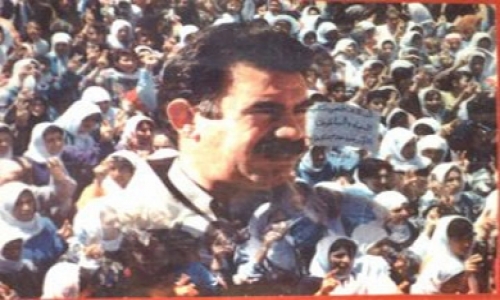
عبد الله أوجلان
يتضمنُ تشخيصُ وجودِ الكردِ وتعريفُه بالأساليبِ التاريخيةِ المألوفةِ مشقاتٍ عديدة. فالجغرافيا التي قطَنوها، والتواريخُ التي مروا بها، قد أَثَّرت بِحِدةٍ في نشوئِهم، وأَرغَمَتهم على البقاءِ على هامشِ الحياة. والبحوثُ الأخيرةُ تُشيرُ إلى أنّ ظهورَ الهوموسابيانس– الذي يُعَدُّ جَدَّ الإنسانِ الحاليّ – إلى الساحةِ خلالَ الثلاثِ مائةِ ألفِ سنةً الأخيرة من تاريخِه على وجهِ التقريب، وارتقاءَه بنفسِه ليصيرَ نوعاً سائداً؛ قد حَصَلَ وتكاثَف في الهلالِ الخصيب (في الأراضي التي تَشغلُ كردستان الحاليةُ مركزَها، والتي تَقطنها غالبيةُ الكرد). ومرحلةُ الهوموسابيانس تزامَنَت مع ولادةِ اللغةِ الرمزيةِ من تاريخِ النوعِ البشريِّ الذي شُخِّصَ عمرُه بما يزيدُ عن ثلاثةِ ملايين عاماً. من هنا، فثورةُ الهوموسابيانس التي احتَلَّت منزلةَ الصدارةِ تماشياً مع رُقِيِّ اللغةِ الرمزية، تقتضي تعاطياً أكثر جذريةً للتاريخِ الساري في الهلالِ الخصيب. هذا وبُرهِنَ بالبحوثِ الجينيةِ أيضاً أنّ ثورةَ الهوموسابيانس قد تركَّزَت في هذه المنطقة. فانقضاءُ الحقبةِ الجليديةِ الأخيرةِ قبل عشرين ألفِ سنة، وانحسارُ الجليدِ قد مَكَّنا من ظهورِ الثورةِ الزراعيةِ النيوليتية. وباتحادِ الغطاءِ النباتيِّ الوفيرِ للأراضي وغِناها الحيوانيِّ مع القوةِ الفكريةِ للهوموسابيانس، فإنّ الانتقالَ إلى مجتمعِ الزراعةِ – القرية، والذي يُعتَبَرُ أكثرَ الثوراتِ جذريةً وغوراً في تاريخِ البشرية؛ قد مَهَدَّ السبيلَ أمام تطوراتٍ عظيمةٍ في الهلالِ الخصيب.
إنّ النقلةَ المُعاشةَ في اللغةِ والفكرِ مع ثورةِ الزراعةِ والقرية، قد فتحَت السبيلَ أمام تشكيلاتٍ اجتماعيةٍ لَم يَكُن لها نظيرٌ في عهدِها. وتشكلت المجموعاتُ الهندوأوروبيةُ كمجموعةٍ لغويةٍ – ثقافيةٍ سائدة (لقد سُمِّيَت خطأً بهذا الاسم، والأصحُّ هو تسميتُها بالمجموعة اللغويةِ – الثقافيةِ الآرية). في حين بالمقدورِ تعريفُ أصولِ الكردِ الحاليين بأنها الخليةُ النواةُ للمجموعاتِ الهندوأوروبية. والبحوثُ الجاريةُ بصددِ اللغةِ والثقافةِ الكرديتَين، تَطفو بهذا الواقعِ إلى السطح. وجغرافيا الحياةِ وتاريخُها أيضاً يؤيدُ صحةّ ذلك أكثر. وما "كوباكلي تبه" التي نَقَّبَت البحوثُ في بقاياها مؤخَّراً، وكَشَفَت عن دورِها المحوريِّ كمركزٍ لأقدمِ قبيلةٍ ودينٍ يَمتدُّ بجذورِه إلى ما قبل اثنتَي عشرةَ ألفِ سنة؛ سوى أمثلةٌ هامةٌ لإثباتِ جدارةِ وقوةِ تلك الثقافةِ القائمة. إذ لَم يُعثَرْ على مثالٍ عريقٍ وضاربٍ في القِدَمِ كهذا في أيٍّ من بقاعِ العالَمِ الأخرى.
ولدى تقييمِ قوةِ الدينِ والقبيلةِ التي لا تنفكُّ مؤثرةً ونافذة، فسيُلاحَظُ أنّ التاريخَ والجغرافيا اللذَين تَستندُ إليهما يتميزان بمنزلةٍ مُعَيِّنةٍ فيها. فبقدرِ ما يتأثرُ مجتمعٌ ما بالتاريخِ والجغرافيا بنحوٍ طويلِ المدى وعميقِ الأثر، تَكُونُ محليّتُه وأهليّتُه قويةً ودائمةً بالقدرِ نفسِه. والتأثيراتُ القويةُ والراسخةُ قد تُصَيِّرُ المجتمعَ في أحداثِها التاريخيةِ اللاحقةِ تعصبياً ومتزمتاً أيضاً. وإذا كُنا لا نَبرحُ نستطيعُ رَصدَ المزايا العريقةِ والمحليةِ للكرد، فمن الواجبِ الحديثُ هنا عن التأثيراتِ القويةِ والدائمةِ الكامنةِ في ركيزةِ هذا الواقع. لا ريب أنّ ظاهرةَ التحولِ إلى شعبٍ لَم تتكونْ بعدُ في العهدِ النيوليتيّ. بل نَشهدُ ولادةَ المجتمعِ القَبَلِيِّ آنذاك. فالعشيرةُ تطورٌ ثوريٌّ عظيمٌ قياساً بمجتمعِ الكلان. هذا وبالإمكانِ نعتُ الثورةِ النيوليتيةِ بالثورةِ القَبَلِيّةِ أيضاً. فقد بدأَ اختلافُ اللغاتِ والثقافاتِ إلى جانبِ العلاقاتِ شبهِ المستقرةِ – شبهِ البَدَوِيّةِ بالنماءِ والازدهارِ في المجتمعِ القَبَلِيّ. وما المركزُ الدينيُّ في كوباكلي تبه سوى كعبةُ عصرِه، تَقصدُها القبائلُ التي تَعيشُ الاستقرارَ والترحالَ بنحوٍ متداخلٍ مدى آلافِ السنين. لذا، لا يُمكنُ الاستخفافُ بنصيبِ هذا الواقعِ في بروزِ العواطفِ الدينيةِ التي لا تنفكُّ راسخةً متينةً لدى الكردِ عموماً وفي أورفا على وجهِ الخصوص. إننا نتعرفُ هنا على وجودِ ثقافةٍ وطيدةٍ تَكَوَّنَت قبل الحضارةِ السومريةِ المدينيةِ بآلافِ السنين، ودامَت آلافَ السنين. كما وتُواجِهُنا في الأحجارِ المنتصبةِ هناك أمثلةُ الكتابةِ الأسبق ظهوراً من أولى حروفِ الكتابةِ الهيروغليفية. إنّ نَحتَ تلك الأحجارِ قبل اثنتَي عشرة ألفِ سنة، وتحويلَها إلى كتاباتٍ شبيهةٍ باللغةِ الهيروغليفيةِ الرمزية؛ يُعَدُّ مرحلةً تاريخيةً نفيسة.
لَم يُولَدْ المجتمعُ المدينيُّ في مصر وسومر من تلقاءِ ذاتِه. بل إنه ينتهلُ بالتأكيدِ مشاربَه من ثقافةِ ميزوبوتاميا العليا، كما يُثبِتُ هذان المثالان أيضاً ذلك. البرهانُ الآخرُ البالغُ الأهميةِ حول مدى رقيِّ الدياليكتيكِ التاريخيِّ في الهلالِ الخصيب، هو سفرُ النبيِّ إبراهيم إلى مصر قبل ما يُخَمَّنُ بحوالي ثلاثةِ آلافٍ وسبعمائةِ عاماً. والثقافةُ المُوَلِّةُ للمدنيتَين المصريةِ والسومرية، هي تلك الثقافةُ اليانعةُ في قوسِ سلسلةِ جبالِ طوروس – زاغروس. المهمُّ هنا هو وجودُ مستوى ثقافيٍّ باهرٍ بعظمتِه، ولا يزال تاركاً آثارَه على التاريخِ الاجتماعيّ. من هنا، لا مفرَّ من إسنادِ نشوءِ الحقيقةِ الكرديةِ إلى هذه الثقافة، ما دامَت آثارُ هذا المركزِ الثقافيِّ لا تُعاشُ بكثافةٍ ملحوظةٍ بين الكرد، وما دام هذا الشعبُ لا يَنفكُّ يواصلُ سيرورتَه بوصفِه أقدمَ الشعوبِ الآهلةِ في هذه الأراضي. بدأَ المجتمعُ القَبَلِيُّ بالبروزِ قبل حوالي ثماني آلافِ سنة في أراضي سلسلةِ طوروس – زاغروس. إنها ثقافةٌ عريقةٌ لدرجةٍ وكأنها تُعلنُ عن حضورِها من خلالِ كعبتِها الأولى البهيةِ من جهة، وعبر ثقافتِها الموسيقيةِ الكونيةِ الأولى متجسدةً في الطبلِ والمزمارِ والنايِ من الجهةِ الثانية. فما النايُ والمزمارُ سوى تعبيرٌ فنيٌّ لهذه الثقافة. بينما المركزُ الدينيُّ تعبيرُها الفكريّ.
الواقعُ الكرديُّ ثمرةٌ من ثمارِ هذا السياقِ التاريخيِّ العظيمِ من ناحية، ومشحونٌ من الناحيةِ الأخرى بالأعراضِ الدالةِ على تَسَمُّرِه وبقائِه عالقاً بقوةٍ في هذه الثقافة. لذا، من غيرِ الممكنِ إيضاحُ إصرارِه على البقاءِ شعباً قَبَلِيّاً ثقافياً وعَزوُه إلى وضعِ الدفاعِ عن الذاتِ إزاءَ قوى المدنيةِ وحسب. فلو أنّ تلك الثقافةَ بِحَدِّ ذاتِها لا تمتلكُ جذوراً ضاربةً في الأغوار الغائرة، فإما أنْ تتحولَ بذاتِ نفسِها إلى مدنية، أو أنْ تنصهرَ في بوتقةِ المدنياتِ التي نشأَت في ربوعِها. ونحن شاهدون على آلافِ المجتمعاتِ القَبَلِيّةِ المنصهرةِ بهذا المنوال. والكردُ بجانبِهم هذا مجموعةٌ شعبيةٌ لا مثيلَ لها. وكحقيقةٍ سوسيولوجية، فإذا كان مجتمعٌ ما قد شَهِدَ ثورةً تاريخيةً بنحوٍ جذريّ، فمن العسيرِ عليه ريادةُ ثورةٍ ثانيةٍ كبرى ومختلفةٍ بين ثناياه. واحتلالُ الثورةُ الذاتيةُ التي عايَشَها لعالَمِه الذهنيِّ والمؤسساتيِّ بنحوٍ تامّ، إنما يلعبُ دورَه في ذلك. فثورةٌ أخرى تقتضي ذهنيةً وتمأسُساً آخر مختلفاً. وهي غيرُ واردةٍ إلا بين الثقافاتِ من الدرجةِ الثانية، والتي تُشَكِّلُ الأطرافَ قياساً بالمركزِ الثقافيِّ الوطيد. وجميعُ المُعطَياتِ التاريخيةِ تُشيرُ إلى أنّ الثورةَ الزراعيةَ المعَمِّرةَ حوالي أربعةَ عشر ألفِ سنة قد تَرَكَت بصماتِها الثابتةَ في الثقافةِ الكرديةِ المستقرة، وليس فقط ثورةُ الهوموسابيانس المعَمِّرةُ ثلاثمائة ألفِ سنة. والخرائطُ الجينيةُ تُبَرهنُ أنّ نوعَ الهوموسابيانس والثورةَ الزراعيةَ على حدٍّ سواء قد انتشرَ من هذا المركزِ الثقافيِّ صوب أطرافِه وجميعِ أرجاءِ المعمورة.
لهذه الأراضي دورُها المُحَدِّدُ والمصيريُّ في الانتقالِ إلى مرحلةِ الحضارة، ليس على صعيدِ رَصفِ الأرضيةِ الثقافيةِ فحسب، بل ومن حيث رسمِها ملامحَ الحضارةِ وتكوينِها لمضمونِها أيضاً. فالأراضي التي ازدهرَت عليها المدنيتان التاريخيتان الأَوَّلِيّتان السومريةُ والمصرية، أي ميزوبوتاميا السفلى ووادي النيل السفليّ، تفتقرُ إلى خلفيةٍ ثقافيةٍ عريقة. فمَناخُها لا يَصلحُ حتى لحياةِ مجتمعِ الكلان. من هنا، فهاتان المدنيتان المتصاعدتان قبل خمسِ آلافِ سنة، إنما هي مَدينةٌ بالفضلِ في أرضيتِها الذهنيةِ والمؤسساتيةِ جمعاء إلى تلك الثقافةِ ذاتِ المسارِ البهيِّ المُعَمِّرِ آلافاً من السنين؛ تماماً مثلما هي عليه المدنيةُ الأوروبيةُ في استنادِها إلى الحضارتَين الإسلاميةِ والصينية، وما هي عليه المدنيةُ الأمريكيةُ في ارتكازِها إلى المدنيةِ الأوروبية. لذا، فأوهنُ نقاطِ علمِ التاريخِ والسوسيولوجيا التي لا تزالُ قائمة، تتجسدُ في عجزِه عن التحليلِ الكافي للجوانبِ النظريةِ والعمليةِ للعلاقةِ بين الثقافةِ والمدنية. ولعدمِ تحليلِ الانتقالاتِ الثقافيةِ والحضاريةِ بين ميزوبوتاميا العُليا وميزوبوتاميا السفلى ووادي النيلِ دورٌ هامٌّ في ذلك. حيث محالٌ عَلمَنةُ التاريخِ والسوسيولوجيا بالأساليبِ التحليليةِ وحسب. بمعنى آخر، محالٌ عَلمَنةُ السوسيولوجيا، ما لَم يُفهَمْ التاريخُ مثلما حدث، وما لَم يُستَوعبْ المجتمعُ مثلما هو عليه.
العجز عن التحكم اليسر بالكرد يعزى إلى ديمقراطيتهم الثقافية.
أما صَونُ الكردِ لوجودِهم بطابعِه الثقافيّ، فيتأتى من قوةِ الثقافةِ التاريخيةِ التي يرتكزون إليها. لذا، يستحيلُ إيضاحُ تفضيلِهم الحياةَ الثقافيةَ على حياةِ المدنيةِ بكونِه تخلفاً ساذجاً أو بدائيةً بسيطة. فالثقافةُ التي عاشوها ليست ثقافةَ مدينةٍ أو طبقةٍ أو دولة، بل هي ثقافةٌ تُعاندُ في التشبثِ بالديمقراطيةِ القَبائليّة، ولا محلَّ فيها للتحولِ السلطويِّ أو الطبقيّ. والعجزُ عن التحكمِ اليسيرِ بالكردِ يُعزى إلى ديمقراطيتِهم الثقافيةِ هذه.
كنتُ سأدركُ بعد أَمَدٍ طويلٍ أنّ حياةَ المجتمعِ المدينيِّ والطبقيِّ والدولتيِّ ليست فضيلةً بل رذيلةٌ وانحطاط. لا شكّ أنّ المفهومَ الرانكَوِيَّ بصددِ الأمة (نسبةً إلى ليوبولد فون رانكه 1795 – 1886) قد أدى دوراً رئيسياً أيضاً في التأثيرِ على مسارِ فهمِنا للقضيةِ القومية. حيث اعتَبَرنا كينونةَ الواقعِ الدولتيِّ والطبقيِّ والقوميِّ من المزايا الأصلية، عند التفكيرِ بأيما مجتمعٍ منفردٍ بذاتِه. كما وسَقَطنا كثيراً في المواقفِ المثالية، من قبيلِ عدمِ إدراجِ المجتمعاتِ التي تفتقرُ لتلك المزايا إلى لائحةِ المجتمعات. هكذا كنا نُحيطُ الخاصيةَ الأوليةَ للفكرِ القومويِّ الدولتيِّ الغربيِّ بالصفاتِ العالمية. لذا، من الصعبِ علينا تطويرُ مفهومٍ علميّ، ما لَم نُطَهِّرْ مصطلحَي التاريخِ والمجتمعِ من براثنِ وتداعياتِ تلك القوالبِ الدولتيةِ والقومويةِ للهيمنةِ الأيديولوجيةِ غربيةِ المركز. إذ إننا نغالي في تضييقِ الخِناقِ على ذهنيتِنا التاريخيةِ والاجتماعيةِ في سبيلِ التحولِ إلى أمةٍ ذاتِ دولة. وعادةً ما باتَ إنشاءُ تاريخٍ لكلِّ مجتمعٍ مرهوناً بكينونةِ وصَيرورةِ الأمةِ والدولةِ لديه. وتختلجنا عاطفةٌ وكأننا سنُضَيِّعُ فرصةَ الاندراجِ في لائحةِ المجتمعات، فيما لو لَم نتَّسِمْ تاريخياً بسِماتِ أمةٍ ودولةٍ "قديرة" (أياً كان معناها). مما لا شائبةَ فيه هو أنّ هذه الذهنيةَ القومويةَ والدولتيةَ المتصاعدةَ كعاملٍ أساسيٍّ للاستغلالِ والتحكمِ لدى الحداثةِ الرأسمالية، تُشَكِّلُ المؤثرَ الأوليَّ المتخفي خلفَ النقصانِ والانحرافِ والعَمى الكامنِ في علمِ التاريخِ والمجتمع. ذلك أنّ ما يُطلِقُ العَمى الأسودَ على آفاقِنا بصددِ عِلمِ التاريخِ وعلمِ المجتمع، هو أجهزةُ الاستغلاليةُ والأيديولوجيةُ للهيمنةِ الرأسمالية.
بالتالي، نحن لا نقتربُ من يومِنا الراهنِ نحو تلك المرحلةِ بمفهومٍ قومويٍّ أو دولتيّ، لدى سعيِنا إلى تحديدِ أعظمِ مراتبِ تاريخِ البشريةِ والثقافةِ الاجتماعية. ولا نُنشِئُ القوالبَ بصددِ الكردايتية. بل نندفعُ وراءَ التاريخِ العالميِّ والمجتمعِ الكونيّ. من هنا، ينبغي الإدراك بأفضلِ وجه، أننا لن نستطيعَ الجزمَ بمكانةِ وموضعِ أيةِ مجموعةٍ منفردةٍ بذاتِها على مسارِ التطوراتِ الجاريةِ في التاريخِ والمجتمع، ما لَم نلتزمْ بالمفهومِ الكونيِّ للتاريخِ والمجتمع. ذلك أنّ النشاطاتِ التي سنُجريها بحقِّ التاريخِ والمجتمعِ المنفردَين، لن تذهبَ أبعدَ من كونِها أحكاماً ذاتية، في حالِ تناوُلِنا إياها بشكلٍ منقطعٍ عن التاريخِ والمجتمعِ الكونيَّين. وإلا، لماذا يتهربُ المدافعون عن الفكرِ الذي يتخذُ المدنيةَ الغربيةَ مِحوراً له من التطوراتِ التاريخيةِ والاجتماعيةِ الكونية؟ ولماذا يَحدُّون أنفسَهم بمفهومِ التاريخِ والمجتمعِ الإغريقيِّ – الرومانيِّ كحدٍّ أقصى؟ جليٌّ جلاءَ النهارِ أنّ منافعَهم في الهيمنةِ الأيديولوجيةِ والماديةِ تلعبُ دوراً مُعَيِّناً في ذلك.
علينا ألا نقعَ إطلاقاً في الضلالِ والزيغِ بشأنِ الموضوعِ التالي: مهما كان مجتمعٌ ما يَحيا "الحاضرَ" من دونِ دولة، ومهما كانت مزايا الأمةِ لديه متدنيةَ المستوى؛ فهو لن يتخلص بالتأكيدِ من كونِه جزءاً من التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين. يكمنُ الضلالُ والتِّيهُ في إمكانيةِ البحثِ والتدقيقِ في العديدِ من المجتمعاتِ بنحوٍ منفصلٍ عن التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين. يستحيلُ فهمُ التاريخُ والمجتمع، بهذه الذهنيةِ المناهِضةِ للعلمِ والمنفتحةِ على شتى أنواعِ الأحكامِ المُسبَقة. علماً أنّ التكاملَ ليس خاصيةً أساسيةً في الطبيعةِ الاجتماعيةِ فقط، بل وفي الطبيعةِ الفيزيائيةِ والكيميائيةِ والبيولوجيةِ أيضاً.
يجب التبيان بعناية أنّ كلَّ الأفكارِ الشاذةِ والهامشيةِ بحقِّ الكردِ تعتمدُ على هكذا أحكامٍ ذاتيةٍ مُسبَقة. فمهما أُقصِيَ الكردُ من التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين في راهننا، إلا أنّهم – وعلى النقيض – ممثلو المجتمعِ القَبَلِيِّ الذي أدى دوراً رئيسياً في كافةِ أطوارِ التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين، ابتداءاً من تخطي مجتمعِ الكلان وحتى تطوُّرِ مجتمعِ المدنية (المجتمع المدينيّ، الطبقيّ، والدولتيّ). إنهم العنصرُ الرئيسيُّ في إنشاءِ الثقافةِ القَبَلِيّة وتأمينِ سيرورتِها. من الخطأِ النظرُ إلى القبيلةِ على أنها ظاهرةٌ اجتماعيةٌ خارجةٌ عن العصرِ أو عفا عليها الزمن. ذلك أنّ القبيلةَ شكلٌ أساسيٌّ للبشرية، ولن يحصلَ تخطّيها في أيِّ وقتٍ من الأوقات. قد تتغيرُ شكلاً ومضموناً، ولكن، من غيرِ الممكنِ إقصاؤُها كلياً من الظاهرةِ الاجتماعية. كما أنّ شكلَي الكلان والأمةِ في الظاهرةِ الاجتماعيةِ لا يتّصفان بالكونيةِ والتاريخانيةِ بقدرِ ما هو عليه شكلُ القبيلة. لا ريب أنّ شكلَي الكلان والأمةِ أيضاً يتحليان بالخاصيةِ الكونية، ولكنْ ليس بمستوى القبيلةِ من حيث التأثير. فالشكلُ الأوليُّ للإنشاءِ الاجتماعيِّ هو القبيلة. وحتى في عهدِ الرأسمالية، دع جانباً تجاوُزَ القبيلة، فجميعُ الاحتكاراتِ والشركاتِ المهيمنةِ القابضةِ الرأسماليةِ ذائعةِ الصيت، ما هي في نهايةِ المطافِ سوى تنظيماتٌ قَبَلِيّة. قد لا تَكُونُ قبائلَ البدوِ الرُّحَّلِ والمجتمعِ الزراعيِّ المُكَوِّنِ للتاريخ، ولا يُمكنُها أنْ تَكُونَ كذلك؛ ولكنها قبائلٌ مدينيةٌ في مجتمعِ الأزمةِ والانهيارِ والتضعضع، أي أنها قبائلٌ هرميةٌ ودولتيةٌ واستغلالية.
نصادفُ مِراراً النماذجَ البدئيةَ من أسلافِ الكردِ في علاقاتِ مجتمعِ المدنيةِ السومريةِ مع محيطِهم، ابتداءاً من التاريخِ المكتوب. ونظراً لكونِهم يُشَكِّلون المنبعَ العينَ الذي يستقي منه السومريون، فقد كان السومريون يَصفون شعبَ المناطقِ الجبليةِ في الشمالِ والشرقِ منهم باسمِ الكورتيين، والذي لا يزال يفيدُ بنفسِ المعنى؛ ويُطلِقون تسميةَ العموريين على شعبِ القبائلِ التي تقطنُ إلى الغربِ منهم عموماً. فالمعنى اللفظيُّ لكلمةِ كورتي تعني "الشعب الجبليّ". ولدى ذِكرِ الكرديّ في يومِنا الراهنِ أيضاً يجري استذكارُ صفةِ "الجبليّ" كخاصيةٍ أساسية. في حقيقةِ الأمر، يَلوحُ فيما يَلوحُ أنّ الفارقَ بين كورتيّي Kurti العهدِ السومريِّ وكورتيّي Kürti راهننا، هو فرقٌ ربما يعادلُ النقطتَين اللتَين على حرفِ "u"، لا غير . فالكردُ الذين يعيشون الثقافةَ القَبَلِيّةَ طيلة آلافِ السنين، لا يزالون الكُردَ القَبَلِيّين الذين تطغى نسبتُهم ضمن عمومِ الشعبِ الكرديّ. ربما يضمّون بين أحشائِهم عدداً وفيراً من أبناءِ المدنِ والسهول، وممَّن شَهِدوا التمايزَ الطبقيّ، والمتواطئين مع الدولةِ ومناهضيها أيضاً. لكنّ المُجَسَّدَ الأساسيَّ للكردايتيةِ يتمثلُ في تلك التي تحيا نَسَبَها بقوة، وتطغى عليها المزايا القَبَلِيّةُ التقليدية. أي أنها الكردايتيةُ القَبَلِيّةُ المِحورية. بينما الكرديُّ المدينيُّ أو الدولتيُّ أو المنتمي إلى الطبقاتِ الحاكمة، غالباً ما يُعَبِّرُ عن كردايتيةٍ انتقاليةٍ منقطعةٍ عن الكردايتيةِ التقليديّة، ومُذعِنةٍ للانصهار. وأنكيدو، الذي تَنصُّ ملحمةُ كلكامش على أنه أولُ كورتيٍّ مدينيٍّ عميل، ربما يَكُونُ أولَ جدٍّ لجميعِ الكورتيين المدينيين والطبقيين والمتواطئين مع السلطة. بينما هومبابا الذي ورَدَ ذِكرُه في الملحمة، هو كورتيٌّ جبليّ. يستميتُ أنكيدو في التوسلِ من كلكامش كي يقتلَ هومبابا الذي خانه. لَكَم يُشبِهُ الكورتيَّ العميلَ الراهنَ بشكلٍ مذهل! إذن، فنحن لسنا مُجحفين ولَم نُغالِ كثيراً، عندما قلنا أنّ الفارقَ بينهما قد يساوي النقطتَين اللتَين على حرفِ "u".
من الأهميةِ بمكان عدمُ الانجرافِ في بعضِ نقاطِ الزيغِ والضلالِ الجذرية، أثناء التفكيرِ في التغيرِ الاجتماعي، أو بمعنى آخر في المجتمعِ التاريخيّ. وأهمُّ هذه المخادعاتِ الجذريةِ هو تقييمُ التغيرِ أو التاريخِ الاجتماعيِّ من زاويةِ الرأيِ البراديغمائيِّ القائلِ بـ"التقدمِ على خطٍّ مستقيم". هذه الذهنيةُ الفلسفيةُ التي باتت نهجاً أيديولوجياً سائداً وطاغياً في عهدِ التنوير، تتناولُ شتى أنواعِ التغيرِ على هيئةِ خطٍّ مستقيمٍ يمتدُّ من الأزلِ نحو الأبد. فالأمسُ هو الأمس، واليومُ هو اليوم! وتتعاطاهما وكأنه لا يوجدُ أيُّ رابطٍ أو تماثلٍ بينهما إطلاقاً. إنه تفسيرٌ خاطئٌ للتطورِ الدياليكتيكيّ. ومضادُّ هذه البراديغما هو المفهومُ الذي يرفضُ التغير، ويقولُ بتكرارِ الذاتِ الدائمِ بشكلٍ "حلزونيّ". حيث يَعتَبِرُ الظاهرةَ المسماةَ بالتغيرِ مَحضَ تكرارٍ دائم. هذان المفهومان الفلسفيان الذي يبدوان متضادَّين إلى آخرِ درجة، هما مثاليان مضموناً. وكِلاهما نسختان مختلفتان من الأيديولوجيا الليبرالية. وكِلاهما يلتقيان من حيث الجوهرِ في نقطةِ إنكارِ التغير، من خلالِ الاستقامةِ اللانهائيّةِ في الأول، والتكرارِ اللانهائيِّ في الثاني.
هذه المسألةُ الأقدمُ عُمراً في الفلسفةِ والأديان، بل وحتى في الميثولوجيا، ينتهي بها المطافُ إلى مخرجٍ مسدود. إنها مهزلةٌ ساخرة، حيث عجزوا عن استيعابِ العلاقةِ بين الزمانِ والمكان. ولم يتمكنوا من الإدراكِ أنّ العلاقةَ بين الوجودِ والزمانِ تتبدى في هيئةِ النشوءِ والتكوُّن، أي التغير. والعجزُ عن الإدراكِ يُقحمُ هذه العقلياتِ بما لا مفرَّ منه في أشكالِ التفكيرِ بالتقدمِ على خطٍّ مستقيمٍ أو بشكلٍ حلزونيّ. وأهمُّ تجديدٍ أتت به الفلسفةُ الدياليكتيكيةُ في هذا الخصوص، هو ذاك المعنيُّ بجوهرِ التطورِ الكونيّ. فالزمانُ والمكانُ غيرُ ممكنَين إلا بالوجودِ والنشوء. أي أنّ التغيرَ ثمرةٌ طبيعيةٌ لتواجدِ الوجودِ (المكان) والزمان. والتغيرُ شرطٌ لا بدَّ منه لأجلِ الوجودِ والزمان. وهو برهانٌ على تواجدِهما. من هنا، فتحليلُ مضمونِ مصطلحِ التغيرِ يتحلى بأهميةٍ أكبر. إذ ينبغي تواجدُ شيءٍ لا يتغير، من أجلِ إمكانيةِ حصولِ التغير. حينها يَكُونُ التغيرُ نسبةً إلى اللامتغير. واللامتغير هو ما يبقى دوماً كما هو. بمعنى آخر، فالذي لا يتغيرُ هو الوجودُ الأصل، الوجودُ ذاتاً، وهو الجوهرُ الباقي دوماً والذي ينبثقُ منه النشوء. قد يُقالُ أننا دَنَونا هنا من مصطلحٍ إلهيٍّ صوفيّ. لكنّ استنتاجاً كهذا ضرورةٌ اضطراريةٌ لا تتنافى مع العِلم. بَيْدَ أنّ القولَ بكونِ وعيِ الإنسانِ ذا كفاءةٍ تامّةٍ بشأنِ استيعابِ وإدراكِ النشوءِ والزمانِ والمكان، هو أمرٌ ميتافيزيقيّ. حيث أنّ قدرةَ الإنسانِ على فهمِ المطلقِ أمرٌ محفوفٌ بالشكِّ والظنّ.
بناءً عليه، فعدمُ إنكارِ التغيرِ في علمِ التاريخِ والمجتمع، وعدمُ المغالاةِ فيه أيضاً يُعَدُّ شأناً عاليَ الأهمية. فالمجتمعُ الثقافيُّ أكثرُ رسوخاً ودائميةً من مجتمعِ المدنية، ويُشَكِّلُ أصلَ المجتمعِ ووجودَه. ووجودُ المجتمعِ المتكونِ بمتانةٍ على الصعيدِ الثقافيّ، هو مجتمع محظوظٌ في تأمينِ سيرورتِه. وبينما يطرأُ التغيرُ بسرعةٍ وكثرةٍ على المدنياتِ والدول، فإنّ الثقافاتِ تتيحُ المجالَ أمام تغيرٍ جدِّ محدود. من الخطأِ القولُ بعدمِ حصولِ أيِّ تغيرٍ فيها. لكنّ الحديثَ عن الثقافاتِ المتغيرةِ دوماً وعن القيمِ الثقافيةِ المتغيرةِ بسرعة، هو أيضاً خاطئٌ بقدرِ الأول، أي بقدرِ المفاهيمِ القائلةِ بعدمِ حصولِ التغير. في حين أنّ وتيرةَ التغيرِ المذهلةَ التي تَعتقدُ الحداثةُ بانبثاقِها من حصرِ كلِّ شيءٍ في "لحظة"، تُعَبِّرُ في مضمونِها عن اللاتغير. ذلك أنّ التغيراتِ السريعةَ إلى أبعدِ حدٍّ في الحَيَواتِ التي تُكَرِّرُ ذاتَها لحظياً، هي في الحقيقةِ غيرُ واردة. لقد أُنشِئَت هنا أيديولوجيةٌ تضليلية. هذه المخادَعاتُ التضليليةُ الأيديولوجيةُ الممهورةُ بمُهرِ الليبرالية، ترمي إلى تحريفِ وعيِ وإدراكِ التاريخِ والمجتمع.
يتوجبُ وضعُ هذه المواقفِ الأسلوبيةِ نُصبَ العين، لدى التعمقِ في الظاهرةِ الكرديةِ وتاريخِها. بينما العملُ على فهمِ الحقيقةِ الكرديةِ عبر التواريخِ القوميةِ والدولتية، يعني تحميلَها عبئاً مفرطاً في الثقل. والتجاربُ المُخاضةُ في هذا المنحى تواريخٌ إرغاميةٌ لا علاقة لها كثيراً بالمستجداتِ الظواهرية. بل ولا تَعكسُ الحقائقَ حتى بقدرِ الميثولوجيا والأساطير. أما أسلوبُ التاريخِ الثقافيّ، فهو أدنى إلى الواقعِ الظواهريّ، حيث يستوعبُ المدنيةَ والحداثةَ أيضاً بين طواياه. بينما ثقافةُ المدنيةِ والحداثةِ لا تشتملُ على التاريخِ العالَميِّ للثقافة. ذلك أنّ الأمةَ والدولة، واللتان تُعتَبَران عامِلَين أوليَّين لعهدِ المدنيةِ والحداثة، لا يُمكنُ إلا أنْ تَكُونا جزءاً من التايخِ الثقافيّ؛ حيث تفتقران إلى القدرةِ على استيعابِ الكونيةِ الثقافيةِ واحتوائِها. من هنا، فعدمُ احتلالِ الكردِ مكانَهم كثيراً في تواريخِ المدنيةِ والأمة، لا يُفيدُ إذاً أنهم بلا تاريخ. فإذ ما تناوَلنا الموضوعَ تأسيساً على التاريخِ الثقافي، فسنُلاحِظُ أنهم أصحابُ تاريخٍ مِحوريٍّ يمتدُّ لآلافِ السنين. والميزةُ الأساسيةُ لهذه الثقافة، هي عيشُها الشكلَين العشائريَّ والقبائليَّ بنحوٍ وطيد، وأداؤُها دوراً ثورياً في اقتصادِ الزراعةِ والمواشي. لذا، فدورُ الكردِ في التاريخِ الثقافيِّ للشعوبِ يماثِلُ ويساوي ما لعبَته ثقافةُ الهلالِ الخصيبِ من دورٍ في تاريخِ البشرية. فهي ثقافةٌ محوريةٌ تاريخياً خلال الحقبتَين الميزوليتيةِ والنيوليتية (15000 – 3000 ق.م)، تَغذّت عليها جميعُ ثقافاتِ المجتمعاتِ النيوليتيةِ الممتدةِ من الصينِ والهندِ إلى أوروبا. هذا وبمستطاعِنا تشخيصُ آثارِ الانتشارِ والتوسعِ الثقافيِّ في هذه الأصقاع، سواءً بالأساليبِ الجينيةِ أم الأتيمولوجية. موضوعُ الحديثِ هنا هو ريادةٌ ثقافيةٌ مِحورُها الهلالُ الخصيب، عمرُها يقاربُ الاثنَي عشر ألفِ عاماً على وجهِ التخمينِ وحسبما شُخَّص. إننا لَم نَعثرْ في تاريخِ البشريةِ على أيةِ ثقافةٍ أخرى طويلةِ الأَجَلِ وشاملةٍ بهذا القدر، ومنورةٍ ومُدَفِّئةٍ ومُغذّيةٍ كالشمس. وحتى لو وُجِدَت، فأدوارُها محدودةٌ وسطحية.
من غيرِ الممكنِ التفكيرُ بالمدنيةِ السومريةِ التي يُقَدَّرُ أنها بدأَت أعوامَ 3000 ق.م، وكذلك بالمدنياتِ المصريةِ والهنديةِ والصينية، بشكلٍ منقطعٍ عن جذورِها الكائنةِ في الهلالِ الخصيب. وما لا جدالَ فيه البتة، هو أنّ ثقافةَ الهلالِ الخصيبِ أدت دورَ المنبعِ العين، ليس من ناحيةِ نشوءِ المدنياتِ والحضاراتِ الرئيسيةِ فحسب، بل ومن ناحيةِ تأمينِ سيرورتِها مدى ألافِ السنين أيضاً. فكما هو معلوم، لا يُمكنُ لثقافاتِ الحضاراتِ والمدنياتِ أنْ تتنامى، إلا في الأوساطِ المعطاءِ للثقافةِ النيوليتية؛ نظراً لافتقارِها إلى القدرةِ على البدءِ من نقطةِ الصفرِ في الإنشاءِ بمفردِها. في حين أنّ نيوليتيةَ ميزوبوتاميا في الهلالِ الخصيبِ تكادُ تَكُونُ مهداَ حضارةِ العصورِ الوسطى بمفردِها (3000 ق.م – 500 م). والحضارةُ الميزوبوتاميةُ المركزِ قد أدت دورَ المِحورِ للحضاراتِ والمدنياتِ العالميةِ الرئيسيةِ بدءاً من 3000 ق.م حتى 300 ق.م. وإذا ما قارنّاها بالهيمنةِ الأمريكيةِ التي لَم تَبلغْ بَعدُ قرناً من الزمن، فسنَعي الفارقَ الشاسعَ بينهما على نحوٍ أفضل.
هذا الدورُ التاريخيُّ للنيوليتيةِ الكرديةِ هامّ. فعيشُ نظامِ المدنيةِ المركزيةِ (وعمرُه خمسة آلاف عاماً) ضارباً بجذورِه في ميزوبوتاميا، ومنضوياً تحت ريادتِها المحوريةِ مدى ثلاثة آلاف عاماً؛ إنما يُمَكِّنُ من إدراكِ أهميةِ الثقافةِ النيوليتيةِ بنحوٍ أفضل. ذلك أنّ تحديدَ الثقافاتِ والحضاراتِ بأسماءِ الشعوبِ قد يَكُونُ أمراً مبالَغاً فيه، وبالتالي، قد لا يَكُونُ أسلوباً صائباً. ولكن، من الصوابِ الحديثُ عن دورِهم في المراحلِ البدئيةِ بأقلِّ تقدير. بينما تعرفُنا على التاريخِ بمعرفةِ بعضِ الإمبراطورياتِ والسلالاتِ الشهيرةِ فقط، لن يَكفيَ للتعبيرِ عن الحقيقة. كما وتعريفُه ببعضِ الأقوامِ المشهورةِ أيضاً تناوُلٌ بليغُ النقصان. أما تعريفُ بعضِ عناصرِ الحداثةِ المألوفةِ بكونِها القوةَ الحاملةَ للتاريخ، فيعني أفظعَ تحريفٍ في التاريخ. من هنا، فلدى تخطّي هذه الأرضياتِ التاريخيةَ التي لا تَعقدُ الروابطَ بين الانفراديِّ والكونيّ، والمتبقيةَ بالأغلبِ من الهيمناتِ الأيديولوجية؛ نَكُونُ حينئذٍ في مواجهةِ تاريخٍ اجتماعيٍّ إنسانيٍّ أكثر صواباً. ولا نستطيعَ إنشاءَ تاريخِ الشعوبِ والكادحين المتروكين بلا تاريخ، إلا بهذا الأسلوب.
العلاقةُ بين التاريخِ الثقافيِّ والديمقراطيةِ موضوعٌ غيرُ مدروسٍ كثيراً في السوسيولوجيا. فالمعيارُ الديمقراطيُّ الأصلُ متعلقٌ بمناهضةِ المدنية، وليس بمدى كينونتِها. أي أنّ مستوى المقاومةِ التي يُبديها مجتمعٌ ما تجاه قوى المدنية، هو معيارٌ ديمقراطيٌّ بالغُ الأهمية. إلا أنّ الليبراليةَ تدّعي عكسَ ذلك، حيث تشترطُ التحولَ إلى مدنيةٍ من أجلِ الديمقراطية. لكنّ الثقافاتِ غيرَ المتمدنةِ تحتوي بين أحشائِها تقاليداً ديمقراطيةً وطيدة. كما أنّ الإداراتِ التي تتواجدُ بوصفِها أطروحةً مضادةً لشكلِ الدولة، هي إداراتٌ ديمقراطية، وهي تُشَكِّلُ تقاليداً ديمقراطيةً راسخةً بمزاياها هذه. أما القوى الأساسيةُ للديمقراطية، فتتمثلُ في المجموعاتِ العشائريةِ والقَبَلِيّةِ البالغةِ يومَنا هذا وهي تتصدى التمايزَ الطبقيَّ باقيةً خارجَ أسوارِ المدينة، وكذلك في الجماعاتِ الدينيةِ والمذهبية، وفي الشعوبِ والأممِ التي بلا دولة. ومناهَضةُ المدنيةِ بنحوٍ ممنهج، إنما هي الديمقراطية. بينما قيامُ الماركسيةِ والأيديولوجيا الليبراليةِ باصطلاحِ ومَأسَسَةِ الديمقراطيةِ مؤطَّرةً بالمدينةِ والطبقةِ والدولة، تحريفٌ فظيع. بمعنى آخر، فالنظامُ الديمقراطيُّ المُدرَجُ في نطاقِ المدينةِ والطبقةِ والدولة، هو نظامٌ مخصيّ، ومُجَرَّدٌ مضموناً من الثقافةِ الديمقراطية، ومُفرَغٌ من محتواه بَعدَ إخضاعِه لنفوذِ المدينةِ والطبقةِ والدولةِ الحاكمة. من هنا، فالمدنيةُ أساساً نظامٌ متصاعدٌ على التضادِّ مع الثقافةِ الديمقراطية.
يجبُ أخذُ الروابطِ الدياليكتيكيةِ التي عمِلنا على تعريفِها أعلاه في الحُسبان، لدى تقييمِ مكانةِ الثقافةِ الكرديةِ تجاه المدنيات. حيث نلاحظُ أنّ الكورتيين في حالةِ مقاومةٍ وتَصَدٍّ دائمٍ إزاء ثقافةِ المدنيةِ السومرية. وبالمقدورِ اقتفاءُ ذلك بشكلٍ خاصٍّ في السرودِ الميثولوجيةِ المذكورة لإلهةِ الجبل نينهورساغ. أما ملحمةُ كلكامش، فتُعَبِّرُ في مضمونِها عن نضالِ الكورتيين في سبيلِ الحريةِ وصونِ الوجودِ في وجهِ موجةِ المدنيةِ السومرية. ورغمَ أنّ هذه المدنيةَ واجهَت التصديَ والمقاومةَ لدى تغلغلِها بين صفوفِ الكورتيين، إلا أنها رَصفَت أرضيتَها الذهنيةَ والمؤسساتيةَ بينهم. ومثلما الأمرُ عموماً، فإنّ ثقافةَ المدنيةِ تَبسطُ نفوذَها على المجتمعِ النيوليتيِّ من خلالِ تشييد المدنِ حول السوق. حيث بوسعِنا بشكلٍ ملموسٍ تشخيصُ تأثيرِ ثقافةِ آل عُبَيد – ذاتِ الأصولِ المنحدرةِ من ميزوبوتاميا السفلى – على ثقافةِ ميزوبوتاميا العليا اعتباراً من أعوامِ 4300 ق.م. هذا وتنفصلُ ثقافةُ آل عُبَيد عن ثقافتِها القَبَلِيّةِ السابقة، عن طريقِ المجتمعِ الهرميِّ المتكونِ حول السلالاتِ القوية.
أدت العلاقاتُ والتناقضاتُ بين الثقافةِ القَبَلِيّةِ والثقافةِ الهرميةِ المبتدئةِ بالتمايزِ الطبقيِّ دوراً هاماً في نشوءِ الهوريين، والذين ينحدرون بدورِهم من الأصولِ نفسِها التي يتأتى منها الكورتيون (بالإمكانِ فهمُ كلمتَي "كور Kur" و"أور Ur" في اللغةِ السومريةِ بأنهما تعنيان "الجبل" و"التل"). من هنا، فالمجتمعُ المتكاثفُ على ذرى الجبالِ والتلالِ الواقعةِ ضمن سلسلةِ طوروس – زاغروس، يُفيدُ بالمجموعاتِ نفسِها التي اشتُقَّ اسمُها من كِلتا الكلمتَين. هكذا، فإنّ الثقافةَ السلاليةَ المتناميةَ بالتداخلِ مع القبيلة، تغدو جزءاً هاماً من الثقافةِ التقليديةِ لدى الكرد.
هذا وقد جرى التمكنُ من تشخيصِ كونِ الهوريين (الكورتيين) أَلقَوا أولى خطواتِهم على دربِ المدنيةِ بدءاً من أعوامِ 2000 ق.م، وأنهم بسطوا نفوذَهم من خلالِ سلالةِ خودا Gudea على المدنِ السومرية (2150 – 2050 ق.م). كما ويُرى أنهم بدءاً من أعوامِ 1600 ق.م أيضاً شادوا إمبراطوريتَين متجاورتَين تَصِلُهما ببعضِهما صِلاتُ القرابة، وهما إمبراطوريةُ الحثيين في بلادِ الأناضولِ الداخليةِ والميتانيين في ميزوبوتاميا العليا. من هنا، فالثقافةُ الحثيةُ والميتانيةُ من أهمِّ وأقوى الأمثلةِ التي سجَّلَها التاريخُ بشأنِ تمدنِ الهوريين المتأثرين بالثقافةِ السومرية. كما ويُلاحَظُ أنّ كِلتا القوتَين اتَّحدتا في وجهِ القوتَين البابليةِ والآشوريةِ المنحدرتَين من الأصولِ الساميّة، واللتَين بسطَتا هيمنتَهما بنحوٍ خاصٍّ على الثفافةِ السومريةِ آنذاك؛ إلى جانبِ احتلالِهما مدينةَ بابل أيضاً عامَ 1596 ق.م. زِدْ على ذلك قدرتَهما على بسطِ النفوذِ أيضاً على المدنيةِ المصرية، التي تُعَدُّ أكثر قوى المدنيةِ تأثيراً في الشرقِ الأوسطِ فيما بين 1500 – 1200 ق.م. وهويةُ نفرتيتي المشهورة (الأميرة الميتانية التي ذهبت عروساً إلى مصر) برهانٌ قاطعٌ على مدى قوةِ هذا التأثير. ويبدو فيما يبدو أنّ الهوريين تشتتوا كقوةِ مدنيةٍ تجاه قوةِ الآشوريين المتصاعدةِ مع حلولِ أعوامِ 1200 ق.م، وأنهم عادوا أدراجَهم إلى ثقافتِهم القَبَلِيّةِ القديمة، ليبقَوا عليها ردحاً طويلاً من الزمن. وكما شُخِّص، فقد عاشوا بعدَها على شكلِ اتحاداتٍ قَبَلِيّةٍ رخوةِ الروابطِ باسمِ الكونفدراليةِ النائيرية (فيما بين 1200 – 850 ق.م. هذا وكلمةُ نائيري في اللغةِ الآشوريةِ تعني النهر. وهذا ما معناه "شعوب البحر"). هذا ويُشاهَدُ تشييدُ الكونفدرالياتِ المرنةِ بكثرةٍ في تلك الحقبةِ قبلَ وبعدَ بروزِ تمركزٍ على شاكلةِ الإمبراطورية.
ومملكةُ أورارتو الشهيرةُ (850 – 600 ق.م) مثالٌ هامٌّ آخر بوصفِها ثمرةٌ من ثمارِ العلاقاتِ والتناقضاتِ الكائنةِ بين ثقافاتِ ميزوبوتاميا العليا وميزوبوتاميا السفلى التقليدية. فهي ذائعةُ الصيتِ حضارياً بفنِّ الحِدادةِ خصيصاً. تتكونُ ثقافةُ أورارتو من تركيبةٍ جديدةٍ مؤلَّفةٍ من المقوماتِ الثقافيةِ ذاتِ المشاربِ الهوريةِ على وجهِ التخمين، والتي كان الأرمنُ الحاليون يُمَثِّلُونها آنذاك. وهي تُشَكِّلُ حلقةً متينةً ضمن سلسلةِ نظامِ المدنيةِ المركزية. كما إنها القوةُ الوحيدةُ التي نجحَت في التصدي للإمبراطوريةِ الآشوريةِ التي كانت قوةً سائدةً وحاكمةً في عهدِها، وبقيَت صامدةً إزاءَها، بل وتَمَكَّنَت من دحرِ الآشوريين أيضاً بين الفينةِ والأخرى. هذا ولها بصماتُها الغائرةُ في جميعِ الذهنياتِ والبنى الثقافيةِ في المنطقة، وفي مقدمتِها الثقافتان الكرديةُ والأرمنية. وبعدَ مقاومةٍ عتيدةٍ دامت قُرابةَ ثلاثةِ قرونٍ بحالِها في جبالِ زاغروس تجاه آشور، تتحولُ كونفدراليةُ ميديا إلى إمبراطوريةٍ عامَ 612 ق.م (يَبدو أنه اسمٌ أَطلقه الآشوريون على الهوريين)، وذلك إثرَ تدميرِها نينوى عاصمةَ آشور وتَسويتِها أرضاً. هنا أيضاً. وبعد أَمَدٍ وجيزٍ من عمرِ هذه الإمبراطورية، ظلّت الثقافةُ الميديةُ تُشَكِّلُ أقوى ثقافاتِها، وبالأخصِّ على صعيدِ الفنِّ العسكريّ؛ حتى بعد استيلاءِ الملوكِ ذوي الأصولِ الأخمينيةِ الفارسيةِ عليها خلال أعوامِ 550 ق.م حصيلةَ المؤامراتِ والدسائسِ السلالاتية. ويتحولُ اسمُها إلى الإمبراطوريةِ البرسية، وتغدو القوةَ العالميةَ شاسعةَ الآفاق، والتي تمتدُّ حدودُها من بحرِ إيجه إلى أعماقِ بلادِ الهند، ومن مصر إلى ما يُسمى اليوم تركمانستان. إنها إحدى أقوى حلقاتِ نظامِ المدنيةِ المركزية. حيث باتت القوةَ الوحيدةَ المهيمنةَ عالمياً طيلةَ قرنَين من الزمن، إلى أنْ أَحكَمَ الإسكندرُ قبضتَه عليها عام 330 ق.م، تاركةً خلفَها آثاراً غائرةً في ثقافةِ المدنية. فالمدنيةُ الميديةُ – البرسيةُ هي التي وَلَّدَت المدنيةَ الرومانيةَ من حيث المضمون. أما الممالكُ المُشادةُ كحلقةٍ وسيطةٍ بعدَ غزواتِ الإسكندر، فتصبحُ مع الزمنِ قوى احتياطيةً تستَخدَمُ في النزاعاتِ القائمةِ بين الساسانيين (وهم امتدادٌ للبرسيين: 216 م – 650 م) وروما (500 ق.م – 500 م). أما عجزُ الساسانيين والرومانيين عن إلحاقِ الهزيمةِ التامةِ ببعضِهما بعضاً كآخرِ قوتَين عظيمتَين في العصرِ القديم، وسقوطُهما مُنهَكين مُرهَقين؛ فقد فتحَ الطريقَ أمام الفتحِ الإسلاميّ. هكذا يبدأُ عصرٌ ثقافيٌّ جديدٌ في صفحاتِ التاريخِ مع سيدِنا محمد، الذي أبدى مهارتَه وبراعتَه في توحيدِ الثقافةِ القَبَلِيّةِ البالغةِ الرسوخِ ضمن شبهِ الجزيرةِ العربية، ولَمِّ شملِها تحت رايةِ الثقافةِ الإسلامية.
كلُّ الأحداثِ الهامةِ في ثقافةِ مدنيةِ العصورِ الأولى المُعَمِّرةِ حوالي أربعةَ آلافِ عاماً، جَرَت في ميزوبوتاميا العليا وجِوارِها. وقد شَهِدَ النموذجُ البدئيُّ من الثقافةِ الكرديةِ عديداً من التطوراتِ الإيجابيةِ والسلبيةِ في غضونِ هذا السياقِ الثاني الطويل. هذا وبالإمكانِ التبيانُ بكلِّ يُسرٍ أنّ كلاً من الهوريين والميتانيين والحثيين قد أَفسحوا المجالَ أمام تأثيرٍ له صداه على الصعيدِ العالميِّ خلالَ الألفَي عام الأوليَّين. ذلك أنّ الثقافةَ الهوريةَ – الميتانيةَ – الحثيةَ تُشَكِّلُ الحلقةَ الرئيسيةَ والمُعَيِّنةَ في نشوءِ الثقافةِ الإغريقيةِ والرومانية، وفي ظهورِ الثقافةِ الغربيةِ إلى الوسط. أي أنها، وبنقلِها إبداعاتِها الذاتيةَ والإرثَ الثقافيَّ السومريَّ على السواءِ إلى الغرب، أي إلى الإغريق – الرومان؛ قد أدت دورَ الحلقةِ الذهبيةِ في تأمينِ سيرورةِ نظامِ المدنيةِ المركزيةِ دون انقطاع. ومن المحالِ شرحُ تدفقِ التاريخ، دون تحديدِ دورِ هذه الحلقةِ الذهبية. فلو لَم تٌغَذِّها الثقافةُ النيوليتيةُ المعَمِّرةُ اثنتَي عشرة ألف سنة، وثقافةُ المدنيةِ المُعَمِّرةِ اثنتَي ألف سنة؛ لَكان من الشاقِّ علينا – حسبما يَلوح – الحديثُ عن ثقافةٍ إنسانيةٍ تركَت بصماتِها على يومِنا الراهن.
مرّت علاقاتُ الكردِ الأوائلِ مع المدنيةِ بنحوٍ كثيفٍ للغاية خلال الألفَي عام الأوليَّين من سياقِ مجتمعِ المدنية. وقد طَبَعَت هذه العلاقةُ ذاتُ الوجهَين بصماتِها على كافةِ المستجدات. ففي الوجهِ الأولِ عاشوا دوماً النزاعاتِ والاشتباكاتِ مع المدينةِ والطبقةِ والدولةِ من حيث كونِها عناصرَ قمعٍ واستغلالٍ في ثقافةِ المدنية. وبينما أنجزوا في بعضِ الأحايين حملاتٍ وصلَت حدَّ الاستيلاءِ على مراكزِ الاستغلالِ والقمع (غزو بابل، دمار نينوى)، فإنهم عندما خارت قواهم توخَّوا العنايةَ الكبرى في صونِ وجودِهم وعدمِ التخلي عن الحياةِ المستقلةِ والحرة، بالانسحابِ غالباً إلى ذرى الجبالِ الشاهقةِ العسيرةِ الفتح (الثقافتان الظاظائيةُ والهوراميةُ اللتان تتحدثان باللهجاتِ المتشابهةِ على امتدادِ حوافِّ جبالِ زاغروس الجنوبيةِ وصولاً إلى ديرسم، إنما هي على علاقةٍ قريبةٍ بهذه المستجدات). ولا تزالُ آثارُ هذه الثقافةِ بارزةً للغاية في يومِنا الراهنِ أيضاً. وما الشريحةُ المسماةُ بالكردِ الجبليين في حقيقةِ الأمرِ سوى القبائلُ الهوريةُ الأصول، والتي استقرّت على طولِ هذا الخطِّ طيلةَ خمسةِ آلاف عاماً على وجهِ التقريب. وتطابُقُ بعضِ الكلماتِ ذاتِ الأصولِ الهوريةِ مع الكثيرِ من الكلماتِ الظاظائيةِ والهورامية، إنما يوضحُ هذه الحقيقةَ كفايةً. أما في الوجهِ الثاني، فقد نظروا بعينٍ إيجابيةٍ إلى علاقاتِهم مع ثقافةِ المدنية، فقَبِلوا بها وهضموها. وتجسدَت انعكاساتُ المدنيةِ هذه على الثقافةِ الكرديةِ في نشوءِ الذهنيةِ والمؤسساتِ المدينيةِ والطبقيةِ والدولتية. هكذا تتبدى أمامنا مرةً أخرى القاعدةُ التي واجهناها في العديدِ من الأمثلة، والتي مفادُها "إنْ تعسَّرَ عليك التغلبُ عليه، فتشبَّهْ به واهزِمْه". وعلى سبيلِ المثال، فالكوتيون والميتانيون والحثيون والأورارتيون والميديون والبرسُ والساسانيون واجَهوا قوى المدنيةِ التي هاجمَتهم، بالتشبهِ بها وبإنشاءِ أنفسِهم كمدنية، مُعَبِّرين بذلك عن التغلبِ عليها والصمودِ في وجهِها.
سياقُ المدنيةِ الثاني ذي الألفَين من الأعوامِ الممتدةِ حتى الإسلام، فكان بالنسبةِ للكردِ الأوائلِ عصراً تَكَوَّنَت خلالَه طبقاتُهم الحاكمة، وبَنَوا فيه مدنَهم، وشادوا دولَهم. هذه الثقافةُ التي غالباً ما تكوَّنَت على حوافِّ الجبالِ وفي المناطقِ السهلية، تطغى عليها خاصيةٌ مختلطة: أرستقراطيةٌ حاكمةٌ تحيا ثقافةَ المدنيةِ التي سعت إلى التشبُّهِ بها ومحاكاتِها، وتتحدثُ بلغتِها؛ وشرائحٌ تُشَكِّلُ الطبقاتِ السفلى، وتحيا ثقافتَها ولغتَها الذاتيَّتَين. هذا الطابعُ الثنائيُّ لتلك الثقافةِ المتكونةِ تحت وطأةِ الجغرافيا الكردية، سوف يحافظُ على وجودِه إلى راهننا، مع نذرٍ قليلٍ من التغيير. من هنا، فـ"التمايزُ الثنائيُّ" على شاكلةِ الثقافةِ الجبليةِ والأخرى السهليةِ من جهة، والتمايزُ الطبقيُّ الثنائيُّ داخلَ الثقافةِ السهليةِ والمدينيةِ من الجهةِ الأخرى؛ إنما يُمَثِّلان خاصيةً أصليةً لهذه الثقافة. لقد واظبَت الطبقةُ العليا دوماً على إبداءِ درجةٍ كبيرةٍ من التكيفِ مع المستعمرين والمحتلّين والغازين الأجانب، واعتَبَرَت إلى قبيلتِها وشعبِها وثقافتِها الجوهريةِ وكأنه لا جدوى منها، راميةً بها إلى المنزلةِ الثانية، ومكتفيةً باستخدامِها ضمن حدودٍ ضيقةٍ جداً في علاقاتِها الداخلية. هذا ولَم تبذلْ أيَّ جهدٍ يُذكَر، أو أنها بذلَت القليلَ جداً منه في سبيلِ بسطِ وسيادةِ لغتِها وثقافتِها في المدنياتِ التي أدت دورَها البارزَ فيها أو شيَّدَتها بذاتِ نفسِها. الأمرُ كذلك بدءاً من الكوتيين وحتى الأيوبيين. لقد لعبَت هذه الزمرةُ الحاكمةُ المدينيةُ والدولتيةُ دوراً سلبياً إزاءَ وجودِها الثقافيِّ الكرديِّ التقليدي، ربما بما لا نظيرَ له في أيِّ مجتمعٍ آخر. ما من ريبٍ في أنّ المنافعَ العائليةَ والمصالحَ الطبقيةَ العُليا المتسببةَ بالانصهارِ في بوتقةِ اللغاتِ والثقافاتِ الغريبة، لها نصيبُها المُعَيِّنُ في تلك المساوئِ والسلبيات. أما الثقافةُ القَبَلِيّةُ والعائليةُ التي غالباً ما لَم يطرأْ عليها التغييرُ لدى الكورتيِّ الجبليِّ والشرائحِ السفليةِ المنغلقةِ على ذاتِها، فقد تَمَكَّنَت من الحفاظِ على وجودِها آلافَ السنين والوصولِ إلى راهننا دون انصهارٍ أو تغير، من خلالِ التقوقعِ على نفسِها، لا غير. في حين أنّ الهوّةَ الشاسعةَ سِعَةَ الجبالِ فيما بين هاتَين الشريحتَين الثقافيتَين، قد مَهَّدَت السبيلَ أمامَ تمايُزٍ جذريٍّ على شاكلةِ: الكردايتيةِ الحقة –الكردايتيةِ المزيفة. هذا ويتخفى هذا الواقعُ التاريخيُّ في الجذورِ الغائرةِ لأسبابِ عدمِ نشوءِ بورجوازيةٍ كرديةٍ قوميةٍ وطيدةٍ في عهدِ الحداثةِ الرأسمالية.
يجب الحديثُ عن ظاهرةٍ ثقافيةٍ كرديةٍ بِدئيةٍ وأولى مُعاشةٍ بشكلٍ جدِّ وطيدٍ في العصرِ النيوليتيِّ والعصورِ الأولى. فالوقائعُ الاجتماعيةُ التي هي ظواهرٌ تاريخيةٌ منفردةٌ بذاتِها، ما كان لها أنْ تَعرضَ نفسَها على شكلِ حقائقِ شعبٍ أو قومٍ ذي هويةٍ مختلفةٍ كلياً في تلك العصور. حيث لَمْ تَكُنْ قد بُلِغَت هذه المنزلةُ بعد. وعلى صعيدِ الشعبِ أو القوم، يتجلى العصرُ النيوليتيُّ والعصورُ الأولى في هيئةِ الاتحاداتِ العشائريةِ والقبائليةِ والسلالاتية. بل ولَم تتكونْ آنذاك حتى الاتحاداتُ الدينيةُ والمذهبيةُ بكلِّ معنى الكلمة. أي أنّ أشكالِ الوعيِ العشائريِّ والقَبَلِيِّ والسلالاتيّ، هي أرقى أشكالِ الوعيِ الاجتماعيِ في تلك الحقبة. والعصرُ النيوليتيُّ هو عصرُ ازدهارِ وأُبَّهةِ العشيرة. حيث تُمَثَّلُ كلُّ عشيرةٍ بطوطمٍ هو هويتُها. ويَلُوحُ فيما يَلُوحُ أنّ معبدَ كوباكلي تبه في أورفا هو مركزٌ دينيٌّ – إلهيٌّ لأقوى العشائر، أو أنه مركزٌ دينيٌّ مشتركٌ لأقوى عشائرِ المنطقة. كما وبالمستطاعِ قراءةُ الإشاراتِ المرسومةَ على الأحجارِ المنتصبة، والتي تُشبِهُ اللغةَ الهيروغليفيةَ على أنها سِجِلُّ النَّسَبِ لكلِّ عشيرة. إنّ هذا المعبدَ بمثابةِ مثالٍ أوليٍّ ونموذجٍ بِدئيٍّ مصَغَّرٍ عن الأهرامِ والزقوراتِ والكعبة، وبمعنى آخر عن بيوتِ الربِّ والمراكزِ الدينيةِ السائدةِ في المدنيتَين المصريةِ والسومريةِ الرئيسيتَين خلال العصورِ الأولى، وفي المدنيةِ الإسلاميةِ خلال العصورِ الوسطى. ولهذا السببِ بالذاتِ فهو يتحلى بأهميةٍ تاريخيةٍ عظيمة. وخروجُ سيدِنا إبراهيم من أورفا، وتحوُّلُه إلى جدِّ الأديانِ التوحيديةِ الثلاثةِ الكبرى ليس محضَ صدفةٍ أو ظاهرةً عشوائية. بل هو ثمرةٌ من ثمارِ ثقافةِ المركزِ الدينيِّ في منطقةِ أورفا، والذي يَعُودُ ماضيه إلى اثنَي عشر ألفِ عاماً بأقلِّ تقديرٍ حسبما ثَبُت. فنظامُ المعبدِ الذي في كوباكلي تبه لوحدِه، قد يَكُونُ لعبَ دورَ الكعبةِ الدينيةِ لثلاثةِ آلافِ عامٍ في ذاك العصرِ حسبما قُدِّر. هذا وبالمقدورِ الحديثُ عن دورٍ مشابهٍ لمنطقةِ حران أيضاً. ولَربما لَم يُكتَشَفْ بَعدُ العديدُ من المراكزِ الأخرى. زِدْ على أنّ ثقافةَ المعبدِ في نوالا جوري بمنطقةِ سيفرك أيضاً تمتدُّ بماضيها إلى ما قبلِ إحدى عشرةَ ألفِ سنة.
إننا نعلَمُ أنّ كلَّ عشيرةٍ من عشائرِ العصرِ النيوليتيِّ اختارت حيواناً معيَّناً طوطماً لها بشكلٍ عام. ولدى القولِ بأنّ الطوطمَ بمثابةِ نَسَبِ القبيلةِ وهويتِها، نَكُونُ بذلك قد عَرَّفنا أيضاً ضرباً من ضروبِ أولِ أشكالِ الوعيِ القبائليّ. فكيفما أنّ الدولَ القوميةَ الراهنةَ تُمَثِّلُ نفسَها وهويتَها من خلالِ أَعلامِها، فطواطمُ الاتحاداتِ القَبَلِيّةِ أيضاً تُعَبِّرُ عن ذاتِ المعنى. وكيفما أنّ عددَ الأعلامِ في هيئةِ الأممِ المتحدةِ يُمَثِّلُ كَمَّ الدولِ القوميةِ ضمنها، فالقبائلُ القويةُ والذائعةُ الصيتِ في عهدِها أيضاً تُمَثَّلُ بطواطمِها في مراكزِ معابدِها الدينية. والفرقُ بينهما شكليٌّ، لا جوهريّ. ونحن على عِلمٍ بأنّ الطوطمَ يتحلى بميزةٍ معينةٍ من العبادةِ والتحريم. وعبادةُ الطوطمِ يُشيدُ بتقديسِ وإجلالِ القبيلةِ لذاتِها، وبالتالي يُعَبِّرُ عن طموحِها في الوصولِ إلى حياةٍ آمنةٍ طويلةِ المدى. أما الإيمانُ بالحياةِ ما بَعدَ الموت، فهي حصيلةُ الارتباطِ العظيمِ بالأسلاف. بالتالي، فوجودُهم مُطابِقٌ لهم تماماً. من هنا، فارتباطُهم وتقديرُهم وتبجيلُهم لأجدادِهم، يَؤولُ بهم إلى عقيدةِ الإيمانِ بحياةٍ خالدةٍ بَعدَ الموت. والأديانُ التوحيديةُ اللاحقةُ ما هي سوى حالةٌ متطورةٌ أكثر لهذه العقيدةِ القَبَلِيّةِ وذاك المفهومِ الدينيِّ والإلهيّ.
تحليلُ الثقافةِ القَبَلِيّةِ لأورفا وجوارِها في العصرِ النيوليتيِّ وعصورِ المدنية، قادرٌ على بسطِ أسبابِ بقاءِ هذه الثقافة، التي يذهبُ تاريخُها إلى ما يُقاربُ الخمسةَ عشرَ ألفِ عاماً، مقاوِمةً مُتَحَدّيةً ووطيدةً على الدوامِ وإلى هذه الدرجة. كما وتتواجدُ آثارُ هذه الثقافةِ القَبَلِيّةِ الأعرق قِدَماً، والتي لا يُمكنُ مَحوُها بسهولة، في أغوارِ العواطفِ الدينيةِ ومفهومِ الشرفِ والمفاهيمِ العائليةِ التي لا تزالُ راسخةً بثُبوتٍ إلى يومِنا. إضافةً إلى أنّ الحضورَ الذي لا يَبرحُ قويّاً جداً لدعاوى الشرفِ والثأر، هو محصولُ حقيقةِ المجتمعِ الثقافيةِ أيضاً. ذلك أنّ القوانينَ المحفورةَ في الهويةِ الاجتماعية، لا يُمكنُ أنْ تُمحى أو تَفقدَ تأثيرَها بهذه السهولة.
لا يُمكنُ قطعياً الاستخفافُ بعالَمِ المشاعرِ والأفكارِ المتولِّدةِ من الحضورِ الثقافيِّ للقبيلة. ولا ينفكُّ الوعيُ الذي يُحافظُ على صمودِ البشريةِ مَشحوناً بالآثارِ العميقةِ لذاك الوجودِ الثقافيّ. حيث تكمنُ الثقافةُ القَبَلِيّةُ في ركيزةِ كافةِ أشكالِ الوعيِ الرئيسيةِ المذكورةِ والمحسوسةِ في حقولِ الفنِّ والمعرفةِ والفلسفةِ والدينِ والميثولوجيا. بمعنى آخر، ما مِن مدرسةٍ ميثولوجيةٍ أو دينيةٍ أو فلسفيةٍ أو فنيةٍ لَم تُعَبِّرْ عن الثقافةِ القَبَلِيّةِ قولاً وعاطفةً. بل، وإذ ما بَحَثنا ونَبَشنا في أعماقِ الفوارقِ الميثولوجيةِ والدينيةِ والفلسفيةِ والفنية، فسنَعثرُ على الحضورِ القَبَلِيِّ في دعامةِ كلِّ فارقٍ منها. أما أشكالُ وعيِ القومِ والأمةِ اللاحقة، فهي مُشتقّاتٌ من أشكالِ وعيِ القبيلةِ المُطَوَّرةِ اعتماداً على الاتحاداتِ القَبَلِيّةِ التعددية. وعلى سبيلِ المثال، فالقبيلةُ العِبريةُ (قبيلةُ سيدِنا إبراهيم) تتسترُ في أساسِ الأديانِ الإبراهيميةِ التي كثيراً ما نُصادِفُها في التاريخ، وكذلك في مذاهبِها وطرائقِها، وفي أرضيةِ الظواهرِ الأخيرةِ في التَحَوُّلِ إلى أمةٍ بوصفِها قومويةً دينية. ذلك أنّ القوةَ الكامنةَ لوقائعِ تلك الأديانِ والمذاهبِ والأممِ قبلَ ظهورِها، تنبعُ من تجوالِ القبيلةِ العِبريةِ فيما بين الهلالِ الخصيبِ والمدنيةِ المصرية. أما الثورةُ الإبراهيمية، فيتخفى في أساسِها تدميرُ الأوثانَ التي ما هي سوى طواطمُ قبائلٍ مُكَدَّسَةٌ في مركزِ المعبدِ الكائنِ في منطقةِ أورفا، وفي إحلالِ عقيدةٍ قَبَلِيّةٍ صِيغَت اصطلاحاتُها بصورةٍ أفضل محلَّها. بينما الدينُ العيسويُّ أَطرأَ التحولَ على الدينِ الإبراهيميِّ باسمِ القبائلِ المقهورةِ وبقايا العبيد. أما الإسلامُ الذي هو دينٌ قامَ سيدُنا محمد بريادتِه، فقد حَقَّقَ الشيءَ عينَه من أجلِ عالَمِ القبائلِ الأخرى التي تَعيشُ حياةً مشابهة، وعلى رأسِها القبائلُ العربيةُ المحصورةُ بين البيزنطيين والساسانيين. من هنا، لن نستطيعَ التفكيرُ بالمسيحيةِ من دونِ القبائلِ البائسةِ المقهورةِ وحشودِ العبيدِ الباحثين عن وجدانٍ يَلوذون به ويَأوون إليه، ولا التفكيرُ بانطلاقةِ الإسلامِ من دونِ القبائلِ العربيةِ الفقيرةِ المقهورة.
إنّ الجماعةَ المسيحيةَ والأمةَ الإسلاميةَ مجتمعا وعيٍ جديدان اشتركت القبائلُ والمتشردون المنقطعون من قبائلِهم، والعبيدُ العاطلون عن العمل، والجنودُ الفارّون في تكوينِهما بناءً على عقيدةٍ مشتركة. موضوعُ الحديثِ هنا هو مجتمعٌ جديدٌ يتعدى نطاقَ القبيلة، وراسٍ على أرضيةٍ طبقيةٍ متقدمة، وذو عقائد جديدة. لكنّ القبيلةَ في كنفِ أجواءِ هذا المجتمعِ الجديدِ أيضاً تُواصِلُ حضورَها القويَّ بَعدَ إطراءِ تغييرٍ بسيطٍ للغاية عليه. أي أنّ ما يجري هنا هو تَعرُّضُ المجتمعِ القَبَلِيِّ المتأزمِ إلى التحويلِ والتحويرِ تأسيساً على بنيةٍ أيديولوجيةٍ واجتماعيةٍ جديدة. وبقولٍ آخر، فالحلُّ الذي عجزَت القبيلةُ عن إيجادِه ضمن وحدتِها Birim الذاتية، إنما تسعى إلى العثورِ عليه في الخارجِ ضمن سياقِ تطوُّرِ ثقافةِ المدينةِ والطبقةِ والدولة، وذلك على خلفيةِ إنكارِ ديمقراطيةِ القبيلة.
ثمةَ وضعٌ متأزمٌ في العصرِ القَبَلِيِّ تَلِجُه القبائلُ المُتزايدةُ كَمّاً وحجماً. ويتبدى في مرحلةِ الأزمةِ فريقان يتسمان بمفاهيم مختلفة: أولُهما؛ وبينما تنقسمُ القاعدةُ القَبَلِيّةُ المقهورةُ متطلعةً إلى العيشِ بحريةٍ تَعُضُّ عليها بالنواجذ، فإنّ هرميةَ القبيلةِ، والتي تُشَكِّلُ الفريقَ الثاني، تنقطعُ كسلالةٍ حاكمةٍ عن القاعدةِ القَبَلِيّةِ المُعَرَّضةِ للبؤس، مُنَظِّمَةً نفسَها كمجتمعِ دولةٍ جديدةٍ من خلالِ الانطلاقاتِ الأيديولوجيةِ التي عادةً ما نسميها بدينِ المدنية. أي أنّ الثقافةَ القَبَلِيّةَ القديمةَ هُزِمَت تجاه ثقافةِ المدنية. والتطوُّرُ الحاصلُ بالتداخلِ مع هذا السياق، هو التحولُ المدينيُّ والطبقيُّ والدولتيّ. وهذا هو الحلُّ الأساسيُّ الذي صاغَته المدنيةُ لأزمةِ الثقافةِ القَبَلِيّة. والفكرُ الذي لطالما دارَ السجالُ حولَه تاريخياً، وتشاطرَه الماركسيون أيضاً، هو اعتبارُ هذا التحولِ خطوةً عملاقةً على دربِ التقدم. إذ لَطالما اعتُبِرَ التحولُ إلى مدنيةٍ تقدماً ومستوى حياةٍ راقية. أما ماركس وأنجلز، فقد أَضفَيا ضرورةً اضطراريةً وحتميةً قانونيةً على هذا التحولِ انطلاقاً من إرشاداتِ الماديةِ التاريخية، ناظرين إليه على أنه خطوةٌ عظيمةٌ للتاريخِ على دربِ التقدم.
إني أنتقدُ هذا المفهوم. حيث من المستحيلِ تقييمُ ما جرى عيشُه في المجتمعِ القَبَلِيِّ على أنه مرحلةٌ حتميةٌ لا بدَّ منها في سياقِ الأزمة. بل ما جرى هو الترجيحُ الطبقيُّ للعناصرِ الهرمية. ونظراً لكونِه تغيراً (لا أقولُ تطوُّراً) كَلَّفَ حَسرَ ديمقراطيةِ القبيلةِ وحريتِها ومساواتِها، وتحَقَّقَ على حسابِها؛ فهو على الصعيدِ النسبيِّ خطوةٌ ماردةٌ على دربِ التراجعِ والتهاوي بالنسبةِ للبشرية. ونظراً لحَقنِ التاريخِ دوماً بوجهاتِ النظرِ الأيديولوجيةِ للزُّمَرِ الحاكمة، فإننا نَنعتُ هذا التغيرَ بالضرورةِ الحتمية، والمُحَفِّزِ على التقدم، بل وحتى بالتطوُّرِ الثوريِّ العظيم! والصحيحُ هو أنه خطوةٌ ليست حتمية، أو لا ضرورة اضطرارية لها، بل وخطوةٌ رجعيةٌ ودافعةٌ إلى السقوطِ والانحطاط، ومناهِضةٌ للثورة. في حين أنّ الثقافةَ التي تُشَكِّلُ وجهَ التاريخِ الآخرَ غيرَ المذكور، والتي واظَبَت دون كللٍ أو ملل على الكفاحِ ضد خيانةِ نُخَبِها السلالاتيةِ الهرميةِ الحاكمة، وتَشَبَّثَت بالوعيِ والبنيةِ الديمقراطيةِ المُفعمةِ بالحريةِ والمساواةِ للقبيلة؛ هذه الثقافةُ هي القوةُ الأصلُ التي تُمَثِّلُ التقدمَ والتطوُّر. قد يَكُونُ قُصورُ هذه الثقافةِ في التعبيرِ الممنهَجِ والعلميِّ عن التاريخِ نقصاً جاداً. لكنّ واقعاً كهذا لا يُشيرُ إلى عدمِ وجودِ هكذا تاريخ. بل على النقيض، فهو يدلُّ على أنه لَم يُدَوَّن، وحتى لو دُوِّن، فقد تَعَرَّضَ للقمعِ والطمس، ولَم يُرَوَّجْ له بقوة. أما المدنيةُ التي طَوَّرَتها الزمرةُ الحاكمةُ والاحتكاراتُ الأيديولوجيةُ واحتكاراتُ الاستغلال، فلَم تصبحْ حلاً للأزمة. بل وتحوَّلَت مع التوجهِ صوب راهنِنا إلى مصدرٍ لأشدِّ حالاتِ الأزمة، وذلك عبر ظواهرِ التمدنِ والتمايزِ الطبقيِّ والتحولِ السلطويِّ المتفاقمةِ والمستشريةِ باستمرارٍ على ظهرِ المجتمعِ كوَرَمٍ سرطانيّ. من هنا، ولَئِنْ كانت البشريةُ ستحيا، فلن تنجحَ في فعلِ ذلك تجاه مجتمعِ الأزمةِ التاريخية، إلا بإعادةِ إحياءِ وبَعثِ ثقافةِ الديمقراطيةِ والحريةِ والمساواةِ السائدةِ في العصرِ القَبَلِيّ، تأسيساً على التطوراتِ الإيجابيةِ المُنجَزَةِ في الميادينِ الذهنيةِ والمؤسساتيةِ على طولِ تاريخِ الحضارة.
ولدى توحيدِ الوجودِ الثقافيِّ للكردِ الأوائل، باعتبارِه إرثاً نفيساً متبقياً من الثقافةِ النيوليتيةِ وثقافةِ العصورِ القديمة، مع وعيِ العصرانيةِ الديمقراطية؛ فسيتمكنُ من إحرازِ تطوُّرٍ جديرٍ بتاريخِه وهويتِه في النفاذِ من أزمةِ الشرقِ الأوسطِ الراهنة.