القضية الكردية والحركة الكردية في عصر الرأسمالية
مدخل إلى القضية الكردية والحركة الكردية في عصر الرأسمالية...
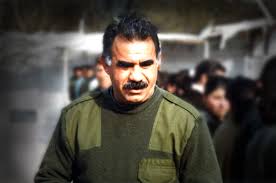
عبد الله أوجالان
بالإمكانِ تعريفُ مصطلحِ القضيةِ على الصعيدِ الكونيِّ بأنها معاناةُ سياقٍ من المخاضاتِ الأليمةِ والمشقاتِ بشأنِ الكَينونةِ أو اللاكينونة. وهو مِعيارٌ يُعاشُ في جميعِ أطوارِ النشوء. هذا وبالمقدورِ صياغةُ تعريفٍ واسعٍ وآخر ضيقِ النطاق، عندما يكونُ المجتمعُ موضوعَ الحديث. فالقضيةُ الاجتماعيةُ بمعناها الواسعِ تُعَبِّرُ عن المشقاتِ التي تمرُّ بها الطبيعةُ الاجتماعيةُ إزاءَ البيئةِ والطبيعةِ الأولى. وعلى سبيلِ المثال؛ فسقوطُ البيئةِ في وضعٍ لا تَكفي فيه للاستمرارِ بالحياةِ بيولوجياً، جراء المستوى الزائدِ من الجفافِ أو الحرارةِ أو البرودة، إنما يسفرُ عن قضايا اجتماعيةٍ جادة. كما بالمستطاعِ تقييمُ الممارساتِ القسرية، التي يلجأُ إليها القويُّ تجاه الضعيفِ ضمن المجموعاتِ التي تحيا في ظلِّ ظروفٍ متشابهة، وإدراجُها ضمن هذا الإطارِ أيضاً. أما القضيةُ الاجتماعيةُ بمعناها الضيق، فبالوِسعِ تعريفُها على أنها الأحداثُ والممارساتُ المرتكزةُ إلى القمعِ والاستغلالِ المُعاشَين ارتباطاً بظهورِ المجتمعِ الهرميِّ وظواهرِ المدينةِ والطبقةِ والسلطةِ والدولةِ إلى الميدان. وسوسيولوجياً، فالقضايا الاجتماعيةُ الأساسيةُ هي تلك الناجمةُ عن القمعِ والاستغلال. أما القضايا والمشاكلُ الأخرى، فبالإمكانِ تقييمُها ضمن مستوياتٍ مختلفة.
تحولت الهرمياتُ والدولةُ مع مُضيِّ الزمنِ إلى أهمِّ مصادرِ القضايا الاجتماعية، رغمَ أنها شُكِّلَت في البدايةِ بغرضِ حلِّ القضايا الاجتماعيةِ البارزةِ حديثاً. وبقدرِ طغيانِ المؤسساتِ الهرميةِ والدولتيةِ في مجتمعٍ ما، فبالإمكانِ الحُكمُ بتفشي القضايا في ذاك المجتمعِ بالمِثل. ونظراً لأنّ الهرميةَ الأولى قد تجسدَت عموماً في حاكميةِ الرجلِ على المرأة، فبالمستطاعِ تسميةُ القضيةِ الاجتماعيةِ الأولى بقضيةِ المرأة. وبعدَ تطويرِ الطبقاتِ الاجتماعيةِ المُستَلهَمةِ من عبوديةِ المرأة، تمَّ الانتقالُ بالتماشي مع تَكَوُّنِ طبقةِ العبيدِ إلى مرحلةِ القضايا الاجتماعيةِ التي تطالُ الجنسَين دون تمييز. وهكذا تداخلَت الهرميةُ مع التحولِ الطبقيِّ في المجتمع، ليبدأَ بذلك سياقُ المجتمعاتِ الإشكاليةِ الذي تداعَت له جميعُ الميادين الاجتماعيةِ بالتدريج. إذ طَبَعَ جميعَ الحقولِ الاجتماعيةِ على وجهِ التقريبِ بطابعِ الجنسويةِ والنزعةِ الطبقية. وطفحَت المشاكلُ التي تعاني منها المجموعاتُ والوحداتُ الاجتماعيةُ داخلياً إلى المجموعاتِ والجماعاتِ الخارجيةِ أيضاً، فاستشرَت ظاهرةُ القمعِ والاستغلالِ من مجتمعٍ إلى آخر. وبنحوٍ ملموسٍ أكثر، تشكلَت القضايا الإشكاليةُ الممتدةُ من كلانٍ إلى آخر، من عشيرةٍ إلى أخرى، من قبيلةٍ إلى أخرى، من قومٍ إلى آخر، ومن أمةٍ إلى أخرى. أما المدنياتُ المتشكلةُ مع تنامي المدينةِ والطبقةِ والدولة، فعَمَّمَت القضايا عالمياً، وأَضفَت عليها طابعاً نظامياً. من هنا، بالمقدورِ تعريفُ جميعِ نُظُمِ المدنيةِ السائدةِ في العصورِ الأولى والوسطى أساساً على خلفيةِ ظاهرةِ القمعِ والاستغلال. أما الحداثةُ الرأسماليةُ بوصفِها نظامَ المدنيةِ الأخير، فقد ارتفعَت بالقمعِ والاستغلالِ إلى أقصاهما. هذا وقد أسفرَت القضايا الاجتماعيةُ البارزةُ في جميعِ سياقاتِ المدنيةِ عموماً، وفي سياقِ المدنيةِ الرأسماليةِ على وجهِ التخصيصِ عن أزماتٍ مأساويةٍ وأجواءٍ من الفوضى الأطول أَمَداً. إذ بالمستطاعِ النظرُ إلى راهننا، وبالأخصِّ إلى مرحلةِ رأسِ المالِ الماليِّ الذي تركَ بصماتِه على الحداثةِ الرأسماليةِ بدءاً من أعوامِ السبعينيات، على أنه العصر الذي شَهِدَ أعمقَ درجاتِ الأزماتِ الاجتماعيةِ الدائمة.
واعتباراً من القرنِ التاسعِ عشر، تعاني المجتمعاتُ، التي تشتملُ عليها منطقةُ الشرقِ الأوسطِ التي تقعُ كردستان في مركزِها، من أزمةٍ عميقةِ الأغوارِ بسببِ الحداثةِ الرأسمالية. ذلك أنّ دولَ الشرقِ الأوسطِ كانت تدنَّت إلى مستوى المجتمعِ المستعمَرِ في مطلعِ القرنِ العشرين، بعدَما أَفلَتَت من يدِها زِمامَ الهيمنةِ والسيادةِ ضمن نظامِ المدنيةِ المركزيةِ الذي يُناهزُ الخمسةَ آلاف سنة، ليَنتزعَه منها مركزُ مدنيةِ أوروبا الغربية. ما جرى عيشُه لَم يَكُ قضايا اجتماعيةً وحسب، بل كان أزمةَ نظامٍ ذاتَ مزايا كلياتيةٍ متكاملةٍ تحتوي بين ثناياها كافةَ الساحاتِ السلطويةِ والاقتصاديةِ والأيديولوجية. ولا تبرحُ هذه الأزمةُ متواصلةً في راهننا بكلِّ حِدَّتِها. الخاصيةُ الأخرى الأهمُّ للأزمةِ المُعاشة، هي أنها طويلةُ المدى، واتخذَت حالةً من الفوضى العارمة. فأجواءُ الفوضى السائدة تحتوي بين طواياها كلَّ المنطقةِ وجيرانِها، لتطالَ كلَّ المجتمعاتِ القاطنةِ في الأراضي الممتدةِ من آسيا الوسطى إلى القفقاسِ والبلقان، ومن الهمالايا إلى أفريقيا الشماليةِ والوسطى.
لأولِ مرةٍ وقعَت أراضي كردستان في مفارقةِ عيشِ أحلكِ أجواءِ الفوضى العارمةِ هذه النابعةِ من الحداثةِ الرأسماليةِ مع التوجهِ صوب راهنِنا، بَعدما كانت تلعبُ دوراً إنشائياً هو الأطول أمَداً في تاريخِ البشريةِ بين طوايا سلسلةِ جبالِ طوروس – زاغروس. تُعَبِّرُ المفارقةُ عن أنّ نهرَ الحضارةِ البشريةِ الذي كان غزيراً عَقِبَ الثوراتِ التاريخيةِ الكبرى، بات يتجه نحو الجفافِ في عصرِ الحداثةِ الرأسمالية. أما الكردُ الذين هم من أقدمِ الشعوبِ العريقة، فسقطوا في حالةِ أكثر الضحايا اجتراراً للألمِ في معمعانِ أجواءِ الفوضى هذه. لا ريب أنها مأساةٌ كبيرةٌ التحولُ إلى شعبٍ يكادُ يُمحى من صفحاتِ التاريخ، بَعدما قطنَ هذه الأراضي التي تكادُ تكونُ مهدَ جميعِ التقلباتِ والانقلاباتِ التاريخيةِ التي وصلَت بالبشريةِ إلى يومِنا الحاليّ، بدءاً من ثورةِ الهوموسابيانس إلى الثورتَين النيوليتيةِ والكالكوليتيةِ وثوراتِ المدينةِ والبرونز والحديد. فما يُعاشُ هنا ليس كومةً من القضايا الاجتماعيةِ البسيطةِ التي تُلاحَظُ في كلِّ مجتمعٍ بشريٍّ معاصر. فبالرغمِ من أنّ جذورَ الكردِ تتوغلُ ضاربةً في أغوارِ التاريخ، إلا إنّ القضايا التي يعانون منها تنبعُ من تركِهم يَحتَضِرون كشعبٍ ويلقطون أنفاسَهم الأخيرةَ بين البراثنِ والمَعِداتِ الكثيرةِ والمختلفةِ الأبعادِ لعناصرِ الحداثةِ الرأسماليةِ الأكثر جوراً وظلماً واستغلالاً.
لا تنبعُ القضايا المُعاشةُ والأزماتُ وأجواءُ الفوضى التي زُجَّ المجتمعُ فيها من قانونِ الرأسماليةِ بشأنِ الربحِ الأعظميِّ وحسب، بل وتشتملُ على الخروجِ من كينونةِ المجتمعِ المتكاملِ بسببِ الصناعوية، وعلى الإباداتِ الثقافيةِ التي تمارسُها الدولةُ القومية، إلى جانبِ احتوائِها بكلِّ مؤسساتِها الفوقيةِ والتحتيةِ أيضاً على شتى أنواعِ الحرمانِ والقهرِ والفقرِ المدقعِ والبطالةِ وغيابِ التعليمِ وتدني المستوى الصحيِّ والخُسرانِ الذهنيّ. من هنا، فالوضعُ القائمُ يتعدى كونَه قضيةً إشكالية، ليبلغَ بُعدَ أفظعِ الفواجعِ والكوارثِ الاجتماعية. موضوعُ الحديثِ هنا هو التحويلُ إلى قطعٍ مُجزَّأة، متناثرة، لامبالية، وتفتقرُ إلى مركزٍ عصبيٍّ وحِسيّ؛ أكثر مما هو خروجٌ تلقائيٌّ من كينونةِ المجتمع. لذا، فالقضيةُ الكرديةُ لا تُشبهُ أيةَ قضيةٍ اجتماعيةٍ أخرى، تاريخيةً كانت أم راهنة. إنها، ومثلما سعينا إلى شرحِه في جميعِ التحليلات، تعني عيشَ الكوارثِ المتداخلةِ والمتواليةِ الناجمةِ من المنزلةِ الخاصةِ بالواقعِ الكرديّ، والممتدةِ على سياقٍ تاريخيٍّ طويلِ المدى، والتي تشملُ كافةَ المجالاتِ الاجتماعية، وتَصِلُ حدَّ الإباداتِ الثقافية.