الحركات الكردية المعاصرة - ١-
لَم يَكُن وضعُ الكردِ كشعبٍ متخلفاً عما عليه الأتراكُ أو التركمانُ والعربُ حتى مطلعِ القرنِ التاسع عشر، بل كان متقدماً عليهم...
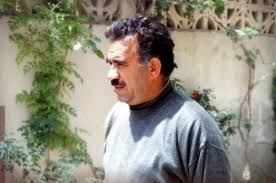
عبد الله أوجلان
دارت المساعي لتعريفِ الحداثةِ من قِبَلِ علمِ الاجتماعِ من خلالِ شيفراتِ الطبقةِ والأمةِ في الحركاتِ الاجتماعيةِ المعاصرة، وصِيغَت النظرياتُ اللازمةُ لذلك. تفسيرُ الواقعِ بهذا النمطِ الوضعيِّ كان تطوراً هاماً على صعيدِ الحقيقة. وإثباتُ صحةِ النتائجِ ميدانياً، قد زادَ من ثقةِ علماءِ الاجتماعِ بأنفسِهم. واعتُقِدَ بكونِ هذا التعاطي هو أسلوبُ الحقيقةِ الصحيحُ الوحيد. هكذا تحوَّلَ دورُ الأسلوبِ الوضعيِّ في البحثِ عن الحقيقةِ إلى عقيدةٍ صارمةٍ مع مرورِ الزمنِ، فحُلَّت العلمويةُ محلَّ العلم. كما وتحوَّلَت الوضعيةُ التي يُزعَمُ أنها تخطَّت الدينَ والميتافيزيقيا، إلى أكثرِ أشكالِ الدينِ والميتافيزيقيا الماديةِ فظاظة. بالتالي، أصيبَت العلومُ الاجتماعيةُ بالتفسخِ والانحلالِ السريع. فبينما أُنشِئَت المعاييرُ الكونيةُ في العلومِ الاجتماعيةِ مقابلَ إنكارِ الواقعِ الملموس، فقد سادَ من الجانبِ الآخرِ التسمُّرُ في الانفرادياتِ والتخلي عن تكاملِ الواقع. وبدأَ عهدُ البحوثِ الانفراديةِ والفروعِ التي لا حصرَ لها من العلومِ الاجتماعية. وبينما عُمِلَ على الخلاصِ من دوغمائيةِ العصورِ الوسطى، صُيِّرَت الدوغمائيةُ الحديثةُ أداةً تهددُ الحياةَ الاجتماعية. وفي الحين الذي أدت فيه نظرياتُ الاقتصادِ السياسيِّ والدولةِ القوميةِ والصناعويةِ على وجهِ التخصيصِ دورَ ستارٍ حاجبٍ ومتسببٍ بأشدِّ حالاتِ الانكماشِ والظلامِ الحالكِ على دربِ الحقيقةِ الاجتماعية، فقد تحوَّلَ الربحُ الأعظميُّ والدولةُ القوميةُ والميولُ الصناعويةُ إلى آلياتٍ جائرةٍ مُسَلَّطةٍ على المجتمع.
لعبَت الحركاتُ الاجتماعيةُ المعاصرةُ المُختَزَلةُ إلى مستوى الأمةِ والطبقةِ الدورَ نفسَه من فوق، بوصفِها كونياتٍ قائمةً بذاتِها. إذ بُذِلَت الجهودُ لتعريفِ الحركاتِ والتنظيرِ لها وتطبيقِها عملياً، باتِّباعِ طرازٍ اختزاليٍّ إلى أقصى درجةٍ في إقحامِ وقائع بالغةِ التعقيدِ والاستعصاءِ كالمجتمعِ في قوالب طبقيةٍ وقومية. وبينما أدَّت المصطلحاتُ والنظرياتُ المعنيةُ بالقومويةِ إلى تأليهِ الظاهرةِ القومية، فقد أفضَت المصطلحاتُ والنظرياتُ المعنيةُ بالاشتراكيةِ المشيدةِ إلى تأليهِ الظاهرةِ الطبقيةِ أو تصييرِها ذاتاً مثالية. أي، في الحين الذي دارت فيه مساعي الخلاصِ من أفكارِ العصرِ الوسيط، فقد جرى الوقوعُ في دوغمائياتٍ لا تقلُّ شأناً عن السابقةِ في ظلِّ تلك الأنماطِ الاختزاليةِ الفظة. وبهذا المنوالِ انعكسَت الأزمةُ ومزايا الفوضى التي سادت في الحداثةِ منذ البدايةِ على أزمةِ العلومِ الاجتماعية. أما الأزمةُ العالميةُ والبنيويةُ التي عاناها النظامُ بكثافةٍ أكبر في أعوامِ السبعينيات، فبدأَت بتسريبِ تداعياتِها في مجالاتِ الاقتصادِ والبيئةِ والسلطة. فبينما احتَضَرَ الاقتصادُ تحت ظلِّ هيمنةِ العصرِ الماليِّ وفي كنفِ نظامٍ نَهّابٍ لا نِدَّ له في التاريخ، فقد صارَت السلطةُ وسيلةَ تلاعبٍ ومضاربةٍ أخّاذة مع اهتراءِ الدولةِ القوميةِ وتهَشُّشِها. كما ومهدَت الحياةُ الصناعيةُ إلى كارثةٍ حقيقيةٍ تحيقُ بالبيئةِ والمناخ. ومن المحالِ التفكيرُ بعدمِ معاناةِ العلومِ الاجتماعيةِ من الأزمةِ إزاء هذه المستجداتِ والأحداث. لقد ازدادَ انكشافُ الستارِ عن الماهيةِ الحقيقيةِ لِلِّيبراليةِ بِشِقَّيها اليمينيِّ واليساريِّ مع انهيارِ الاشتراكيةِ المشيدةِ في التسعينيات. وفَرَضَت أزمةُ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ الليبراليةِ أيضاً حضورَها بنحوٍ ملفتٍ في هذه الفترة، وذلك بصفتِها عنصراً هاماً في الأزمةِ التي عمَّت العلومَ الاجتماعية. أما وصفاتُ الحلِّ التي طرحَتها ما وراء الحداثة بشأنِ الأزمة، فلا تُجدي إلا في إثباتِ أزمةِ الحداثةِ في الساحتَين الأيديولوجيةِ والعلمية. بالتالي، سقطَت التحليلاتُ النظريةُ الطبقيةُ والقوميةُ المعاصرةُ وحلولُها العمليةُ في وضعٍ لَم تَعُدْ فيه قادرةً حتى على أداءِ أدوارِها القديمةِ في التغلبِ على الأزمةِ الممنهجةِ والنظاميةِ للحداثة. وحتى في حالِ تحقُّقِ يوتوبياتِ التحررِ الوطنيِّ والطبقيِّ على أرضِ الواقع، فقد تجلى بوضوحٍ ساطع، وباتَ من المفهومِ تماماً أنها لا تكفي لاستيعابِ وحلِّ الطبيعةِ المعقدةِ والشائكةِ للقضايا الاجتماعية.
ولدى تفسيرِها ضمن هذا الإطار، فسيُرى أنها لَم تعكسْ كثيراً الظاهرتَين القوميةَ والطبقيةَ بشكلِهما السائدِ في الحركاتِ الكرديةِ المعاصرة. حيث ظلَّت على مسافةٍ شاسعةٍ من التعرفِ على حركةِ التحريرِ الوطنيّ. وما سادَ كان حِراكً رجعياً سطحياً وضحلاً للقومويةِ البدائية. بل ونعجَزُ عن مشاهدةِ الحركاتِ الطبقيةَ العصريةَ أيضاً فيها. كما ومن العصيبِ القولُ بظهورِ معالِمِ الحركاتِ المتمحورةِ حول الطبقاتِ البورجوازيةِ والبروليتاريةِ والبورجوازيةِ الصغيرةِ على الطرازِ الغربيّ. لذا، من العسيرِ تعريفُ الحركاتِ الكرديةِ أيديولوجياً وتنظيمياً وعملياً بالعَيِّناتِ والأنماطِ الوطنيةِ والطبقيةِ المعاصرةِ ذاتِ الخططِ والمشاريع. ومع ذلك، فقد مرَّ القرنان الأخيران بنحوٍ دمويٍّ ومليءٍ بالتقلباتِ والتهيجات. فتلك الأعوامُ ازدخرَت بالتمرداتِ والاشتباكات. وبالرغمِ من تهيئةِ الجيوشِ والدولِ القوميةِ المزدادةِ عصريةً وتحديثاً في وجهِ تلك التمردات، إلا إنّ المتمردين عجزوا عن الحِراكِ بجيوشٍ ودولٍ تتطلعُ إلى الهدفِ العصريِّ عينِه. ودعكَ من هذا الحِراكِ جانباً، بل وسيُلاحَظُ أنهم لَم يتمكنوا حتى من محاذاتِها ومواكبتِها. أما ما أعطى الدفعَ للحراك، فكانت مخاوفُ الأمراءِ للحفاظِ على سلطاتِهم، ومصالحُهم المغطاةُ بكساءٍ دينيّ. من هنا، كان لن يَستعصيَ على الجيوشِ والدولِ القوميةِ الحديثةِ الأكثر تفوقاً وتجهيزاً أنْ تقمعَ تلك الانطلاقاتِ الأيديولوجيةَ والميدانيةَ المتبقيةَ من العصورِ الوسطى، والطامحةَ في صونِ سلطاتِها وتأمينِ سيرورةِ هرمياتِها. كما كان من غيرِ المتوقَّعِ إحرازُ الكياناتِ والأيديولوجياتِ والمؤسساتِ التقليديةِ في كردستان النجاحَ الموفقَ في وجهِ قوى الحداثة. وبالوسعِ تسليطُ مزيدٍ من الضوءِ على الموضوعِ عبر بعضِ الأمثلة.
- a) كانت المخاطرُ قد حفَّت وضعِ الإمارةِ التقليديةِ في مستهلِّ القرنِ التاسع عشر. فباشرَت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ التي شعرَت بحتميةِ التحديثِ والعصرنةِ بحركاتِ الإصلاحِ في عهدِ السلطان محمود الثاني على وجهِ الخصوص (1839)، والتي كانت معنيةً بإعادةِ ترتيبِ شؤونِ الدولة. وكان إعادةُ ترتيبِ نظامِ البيروقراطيةِ المركزيةِ والضريبةِ وشؤونِ الجيشِ يتصدرُ قائمةَ المسارِ المتجهِ صوبَ الدولةِ القومية. وما كان لنظامِ الإمارةِ الكرديةِ التقليديةِ أنْ يواصلَ وجودَه إزاء تلك الإصلاحات. فالقبولُ بنظامِ الضريبةِ والخدمةِ العسكرية، كان مؤشراً لنهايةِ حضورِ الإماراتِ الكردية. لذا، إما كان عليها فسخُ ذاتِها، أو التمرد. وتتجسدُ بدايةُ هذه المرحلةِ في أولٍ تمردٍ انطلقَ من السليمانية وارتكزَ إلى أرضيةٍ الإمارةِ والطريقةِ الدينية (عصيان سلالة بابان زاده والطريقة القادرية في 1806). إحدى الخاصياتِ الملفتةِ للنظرِ في مدينةِ السليمانية، هي تواجدُها في أقاصي كردستان، وعلاقتُها مع القبائلِ والعشائرِ المجاورةِ الممتدةِ إلى دواخلِ إيران، واحتواؤُها على قُدُراتٍ فكريةٍ قوية. علاوةً على أنها أحدُ مراكزِ الطريقتَين النقشبنديةِ والقادريةِ التقليديتَين. هذا وكانت قد تنامَت ضمن الإماراتِ الكرديةِ هناك مهارةُ التلاعبِ بالتوازناتِ لمزاولةِ السياسة. كما وشَهِدَت هذه المدينةُ بداياتِ اختلاطِ الطابعِ التقليديِّ مع الحداثة. وهي أحدُ المراكزِ التي وضعَت الإمبراطوريةُ الإنكليزيةُ يدَها عليها كهيمنةٍ عالميةٍ جديدة. وقد بدأَت الكردايتيةُ أو الحركةُ الكرديةُ في ظلِّ هذه الظروف. لكنّ هذه الحركةَ التي لعبَت الخصائصُ الدينيةُ والقوميةُ والقَبَلِيّةُ والأرستقراطيةُ فيها دوراً متداخلاً ومتشابكاً، لَم تتخلصْ من بقائِها محلية. بالتالي، عجزَت عن الصمودِ مدةً طويلةً ضد سياساتِ الإمبراطوريةِ التقليديةِ وحملاتِ القمعِ والسحقِ المُشَنّةِ عليها. ومع ذلك، كانت هذه الحركةُ تفيدُ ببدءِ مرحلةٍ جديدةٍ أيضاً. وبالفعل، فقد تَبَدَّت معالمُ حركاتٍ شبيهةٍ متعاقبةٍ في شمالِ كردستان، ربما كانت أهمَّها وآخرَها تلك الحركةُ التي تزعمَها بدرخان بيك، أمير إقليمِ بوطان.
ثابرَ بدرخان بيك، الذي استخلَصَ العِبَرَ اللازمةَ بصورةٍ خاصةٍ من المثالِ المصريِّ المنتفضِ في وجهِ العثمانيين، على توسيعِ نطاقِ إمارتِه بدءاً من سنةِ 1820، وشرعَ في العبورِ بها إلى نظامِ دولةٍ حديثة. لذا، كانت تتصفُ بخاصيةِ كونِها حركةً قوميةً مبكرةً مؤهَّلةً للارتقاءِ إلى مصافِّ دولةٍ قومية، في حالِ لَم تُقمَع. وانطلاقاً من كونِها الحركةَ الأقربَ إلى نعتِها بالعصرية، فإنّ الأحداثَ والسياساتِ الدائرةَ حولَ زعامةِ بدرخان بيك، تتحلى بنوعيةٍ وافرةٍ بالدروس والعِظاتِ على صعيدِ راهننا أيضاً. فالإنكليزُ كانوا منهمكين أكثر بخلقِ كيانٍ عازلٍ في المنطقةِ اعتماداً على السُّريانيين. هكذا كان ترجيحُهم. إذ كانوا يودّون تطويرَ آليةٍ عازلةٍ في الشمالِ استناداً إلى الأرمن، بحيث تَكُونُ مماثلةً للقيصريةِ الروسية. أما الإمبراطوريةُ العثمانية، بل وحتى الإمبراطوريةُ الإيرانية؛ فكانتا منساقتَين وراءَ بسطِ سيطرتَيهما المركزيتَين. في حين كان الكردُ مُطَوَّقين من الجهاتِ الأربع. وفارقُ الحصارِ تمثَّلَ في أنّ الآتين هذه المرة كانوا مُعتَدّين بأدواتٍ ووسائل ومُحَفِّزاتٍ حديثة. لذا، كانت خياراتُ بدرخان بيك محدودةً رغم وجودِها. بَيْدَ أنّ استهدافَه السُّريانَ كان حدثاً مأساوياً. كما كانت علاقاتِه مع الأرمنِ بعيدةً عن تحليها بالطابعِ الاستراتيجيِّ بالرغم من حُسنِها. والأهمُّ من هذا وذاك أنه كان يفتقرُ إلى قوةٍ مهيمنةٍ يرتكزُ إليها. فبينما اتجهَ المثالُ المصريُّ صوبَ بناءِ دولةٍ قوميةٍ جديدةٍ اعتماداً على إنكلترا، فإنّ هذه الأخيرةَ والإمبراطوريةَ الروسيةَ كانتا تُساندان السلطنةَ العثمانيةَ ضد تمردِ بدرخان بيك. كما وكان موقفُ إيران أيضاً سلبياً. زِدْ على ذلك عجزَه عن الانتقالِ إلى تأسيسِ جيشٍ من طرازِ الأنصارِ في الداخل، وقصورَه في تخطي مفهومِ الجيشِ النظاميِّ ضمن تشكيلاتِه العسكرية. فضلاً عن انعدامِ نواياه واستعداداتِه للمقاومةِ على المدى الطويل. وكان ينطلقُ في حركتِه من الأيديولوجيا والتنظيماتِ التقليدية، ويُواصلُ حُكمَه عبر الأمراءِ بدلاً من النظامِ القانونيّ. هذا وسادَت مشادّاتٌ وتنافُراتٌ حول الإمارةِ داخلَ الأُسرةِ أيضاً (يزدان شير)، بحيث كانت مُهَيَّأَةً للتحولِ إلى خيانةٍ في كلِّ لحظة. وبالإضافةِ إلى كلِّ هذه الأمور، فإنّ عجزَه عن الانطلاقِ في الوقتِ الأكثر ملاءمةً له، ودورانَه في دوامةِ تكتيكاتِ السلطان؛ قد أَعَدَّ نهايتَه. فالاشتباكُ المحتدمُ اعتباراً من ربيعِ عامِ 1847، سُحِقَ في العامِ نفسِه بخيانةِ يزدان شير. وقمعُ هذه الحركةِ الكرديةِ الأدنى إلى العصريةِ بدعمٍ من القوى الغربية، قد وَلَّدَ معه نتائج استراتيجيةً من الناحيةِ السلبية.
لَم تَعُدْ المؤسساتُ الثقافيةُ الكرديةُ المتمتعةُ بحيزٍ واسعٍ من شبهِ الاستقلالِ قادرةً على مواصلةِ حيويتِها القديمة، ولو بالطرازِ التقليديّ. حيث كانت البيروقراطيةُ المركزيةُ تجهدُ لتوسيعِ نفوذِها في كلِّ الزوايا بعدَ ترسيخِ نفسِها خطوةً خطوة. كما وكان وضعُ كردستان كإقليمٍ يُحَجَّمُ باطِّراد، لينتهيَ فعلاً في أعوامِ 1860، وتبقى "كردستان" دلالةً لفظيةً لا غير. يَبدو وكأنّ نظامَ الإمارةِ الكردية، الذي يتميزُ بتقاليد ضاربةٍ في جذورِها إلى عهدِ الميتانيين والحثيين (1600 – 1200 ق.م)، قد انقضى وقتُه. أما بقايا الإمارةِ المتبقية، فستحاولُ البحثَ عن فرصةِ الحياةِ في العصرنة، وستنتقلُ إلى المتروبولاتِ الاستعماريةِ سعياً إلى مواصلةِ وجودِها كَكُرْدٍ متواطئين. وحكايةُ أُسرَتَي بابان زادة وبدرخان مثيرةٌ في هذا الصددِ إلى حدٍّ كبير. إذ عملتا من الجانبِ الأولِ على استثارةِ التمرداتِ من وراءِ الحجابِ كلما سنحَت الفرصة، ولعبَتا من الجانبِ الثاني دورَ الكوادرِ الأكفأ في تشكيلِ الدولِ القوميةِ الحاكمة. وهناك عددٌ كثيرٌ من الكوادرِ التي تنتسبُ إلى هاتَين الأسرتَين اللتَين أدَّيَتا دورَهما في هذا المنحى أثناء تأسيسِ الإمبراطوريةِ والجمهوريةِ على حدٍّ سواء. بالإضافةِ إلى أنهما بمثابةِ الأبِ الروحيِّ للقومويةِ الكرديةِ البدائية. والمثالُ الأكثر لفتاً للأنظار، هو ريادةُ جلادت علي بدرخان، حفيد بدرخان بيك، لأولى المساعي القوموية، سواءً أيديولوجياً (كإصدارِ المجلاتِ والصحفِ وما شابه) أم تنظيمياً (كتأسيس منظمة خويبون بالدرجةِ الأولى). فضلاً عن أنه كان بارعاً أيضاً في إبرامِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ التي عجزَ جَدُّه عن عقدِها. هذا وكان ضلوعُه في اللغاتِ والثقافاتِ الغربيةِ أيضاً أمرٌ خليقٌ بالثناء.
والأغربُ هو أنه وضعَ أساسَ سياسةِ الكردايتيةِ التي سوف تتَّخِذُها جميعُ الأوساطِ والشخصياتِ الأرستقراطيةِ الكرديةِ اللاحقةِ نموذجاً لها. هكذا صُيِّرَت الكردايتيةُ والطابعُ الكرديُّ وسيلةً بِيَدِ تلك الأوساطِ والشخصياتِ لإحياءِ ذاتِها وأُسَرِها. إذ أُجرِيَت كلُّ الصفقاتِ اعتماداً على إطالةِ وجودِها هي. فالمفاوضاتُ التي ابتدأَت بالمطالبةِ بالاستقلال، اختُزِلَت إلى مستوى طلبِ الصفحِ عن أشخاصِهم. هكذا، فهذا الطريقُ المبتدئُ مع بدرخان بيك، باتَ مع جلادت علي بدرخان نموذجاً أو أسلوباً. وقد عملَ هذا الأخيرُ على متابعةِ الصفقةِ عينِها مع مصطفى كمال أيضاً عن طريقِ الجمهوريةِ التركية. وخلال تلك الصفقات، أحياناً تُكَلِّفُ الكردايتيةُ ثمناً باهظاً بموجبِ شروطِ الصفقة، وأحياناً تغدو بخسةً جداً. إذ إنّ ما يَسري هنا ليس كردايتيةً أو حركةً اجتماعيةً كرديةً مُخاضةً بالاستراتيجياتِ والتكتيكاتِ التاريخيةِ والاجتماعيةِ والمناهجية. وفي هذه النقطةِ بالضبط، تكتسبُ النزعةُ الطبقيّةُ والقوميّةُ أهميتَها. فبينما تُضَيِّقُ الطبائعُ الطبقيةُ الخناقَ لهذه الدرجةِ على تلك الشخصياتِ التي انقضى عهدُها، وتُقحِمُها في المخاوفِ والمحسوبياتِ الشخصية؛ فإنّ الطبائعَ القوميةَ غيرَ المتطورةِ تؤدي بها إلى حِراكِها وفق الأيديولوجياتِ والتنظيماتِ البدائيةِ التي تفضي إلى نفسِ المصب.
تُقارَنُ تلك الطبائعُ أحياناً بإدريس البدليسيِّ الذي عاصرَ فترةَ نضوجِ الإماراتِ وانتعاشِها. فإدريس البدليسيُّ الذي عاشَ في مطلعِ القرنِ السادس عشر، وصاحبُ النفوذِ داخلَ القصورِ الصفويةِ والعثمانيةِ على السواء؛ يمثلُ الرمزَ السياسيَّ السلطويَّ السائدَ في عهدِه. ذلك أنّ الإماراتِ الكرديةَ العاجزةَ عن تأسيسِ نظامِها المَلَكيِّ المستقل، بحثَت عن مَخرجٍ لها داخلَ ردهاتِ قصورِ القوى المهيمنة. فهذه الإماراتُ الكرديةُ التي أدت دوراً نافذاً في تشييدِ السلالةِ الصفوية، شعرَت بالمخاطرِ تحيقُ بها بَعدما تحوّلَت الشيعيةُ إلى مذهبٍ رسميّ. فانتماؤُها إلى المذهبِ السُّنِّيِّ دفعَها إلى التعاونِ مع السلالةِ العثمانية. وكانت لها مصالحُها الهامةُ في ذلك. وإدريس البدليسيُّ هو الباني السياسيُّ والأيديولوجيُّ للبحثِ عن هذه السلالةِ الجديدة. والغالبيةُ الساحقةُ من إماراتِ كردستان اتفقَت مع السلالةِ العثمانيةِ على تشاطرِ السلطةِ بما يُوازي تحالفَ القوى المتناظرة. وكان هذا تحالفاً طوعياً هَيَّأَته الظروفُ المناسبة. إذ كانت تتميزُ بمنزلتِها الخاصةِ بها ضمن نظامِ السلطةِ العثمانية. ويَلُوحُ أنّ الإماراتِ الكرديةَ كانت قادرةً على التمتعِ بمزيدٍ من الاستقلالِ بانتخابِ أميرِ الأمراءِ من بين صفوفِها، وتشييدِ سلطنةٍ أكثرَ مركزيةً في المستقبل. ولكن، يجب عدم النسيانِ أنّ الظروفَ آنذاك كانت تُمَكِّنُ من نُظُمِ السلطةِ المعتمدةِ على بضعةِ قوى مهيمنة، بدلاً من وجودِ عددٍ جمٍّ من أنظمةِ السلطنة. أي إنّ الوضعَ حينئذٍ كان يُنشئُ ذاتَه بهذا المنوال. أما الممالكُ المستقلة، فكانت استثناءً، لا قاعدة. وعليه، فأنشطةُ التحالفِ المُبرَمةِ بزعامةِ إدريس البدليسيّ، تُعتَبَرُ موفَّقةً ومناسِبةً حسب ذاك العصر. أما مخاطرُها، فهي عدمُ وضعِها نُصبَ العينِ الشروطَ السلبيةَ والإيجابيةَ التي قد تظهرُ لاحقاً، وبقاؤُها وقتيةً مرحلية. لكنه من المحالِ مقارنةُ شأنِ إدريس البدليسيّ ووزنِه بالتواطؤِ الخطيرِ الذي ظهرَ إلى الوسطِ إبان انهيارِ نظامِ الإمارةِ خلال القرنِ التاسع عشر. ومقارنةٌ بهذا الشكلِ ترتكزُ إلى قياسِ تمثيلٍ خاطئٍ لا يُدخِلُ الظروفَ المرحليةَ في الحُسبان، ويَخلطُ الفتراتِ ببعضِها بعضاً.
لَم يَكُن وضعُ الكردِ كشعبٍ متخلفاً عما عليه الأتراكُ أو التركمانُ والعربُ حتى مطلعِ القرنِ التاسع عشر، بل كان متقدماً عليهم. لكنّ الانهيارَ والاختلافَ الأصلَ في الوضعِ يبدأُ في القرنِ التاسع عشر. وإدراكُ انقضاءِ عهدِ الإمارةِ أَرغمَ الوارثين الأخيرين المتبقين على عدمِ المطالبةِ بالاعترافِ بأيِّ وضعٍ للكردِ كشعب، بل وعلى سلوكِ مواقف أكثر سلبيةً بالتخلي عن وضعِ الحكمِ الذاتيِّ التقليديِّ أيضاً، وتطويرِ نموذجٍ يضمنُ المنافعَ الشخصيةَ والعائليةَ على خلفيةِ التواطؤ. ما من شكٍّ في أنهم لَم يَلِجوا هذا الوضعَ الجديدَ طوعاً. فالظروفُ التي سادت مطلعَ القرنِ السادس عشر لَم تَعُدْ سارية. حيث حاولوا التمرد، وأصرّوا على سيادةِ الوضعِ التقليديّ، بل وتقدموا أكثر بالانعكافِ على البحثِ عن دولة. لكنهم لَم يتجنبوا تَكَبُّدَ الهزيمةِ النكراء في جهودِهم هذه، نظراً لطِباعِهم الطبقيةِ ولظروفِ العصرِ الحديثِ السائدة. وعليه، فالخيارُ الوحيدُ المتبقي أمامهم – انطلاقاً من طِباعِهم الطبقيةِ مرةً أخرى – هو التوجهُ صوبَ نوعٍ جديدٍ وخطيرٍ من التواطؤ، بحيث يعتمدُ على فَلاحهمِ ونجاحِهم الشخصيِّ وعلى مصالحِهم العائلية، ويُصَيِّرُ الكردايتيةَ سلعةً تجاريةً زهيدةَ الثمن. وقد استفادَت الدولُ القوميةُ الحاكمةُ من نقاطِ ضعفِهم هذه بأفضلِ الأشكال، وسَخَّرَتهم كأفتكِ وأخطرِ أداةٍ بيدِها لتسليطِ نظامٍ قمعيٍّ واستغلاليٍّ عصريٍّ على المجتمعِ الكرديّ.
لَطالما اهتمّت تلك الشرائحُ بالتحولِ إلى طبقةٍ بورجوازية، ولا تزال. لكنّ الظروفَ المادية، وروابطَهم السلطويةَ والاقتصادية، وأوضاعَهم الأيديولوجيةَ والتنظيميةَ لا تتيحُ لهم فرصةَ التحولِ إلى طبقةٍ بورجوازيةٍ عصرية. قد يَكُونُ كاميران علي بدرخان بنفسِه قوموياً مثالياً، لكنّ الوقائعَ والأحداثَ الموضوعيةَ التي عايَشَها حوَّلَت طموحاتِه هذه إلى غصةٍ في حَلقِه. إلا إنّ هذا لا يُعيقُ مهالكَ نموذجِ التواطؤِ المُتَّبَع، ولا انفتاحَه على الخيانة. علماً أنّ هذا الموديل، ومثلما يقولُ المثلُ الشعبيّ "يفسدُ السمكُ من رأسه"، بسطَ تأثيرَه البليغَ حتى راهننا، ولعبَ دوراً رئيسياً في تحديدِ مسارِ جميعِ الطبقاتِ والشرائحِ الاجتماعية، وفي رسمِ ملامحِ وطِباعِ الشخصياتِ الخارجةِ من أحشائِها؛ وكأنه نمطٌ اعتياديٌّ للحياةِ الاجتماعية.
لدى تقييمِ وتناوُلِ التقاليدِ الأرستقراطيةِ الكردية، ينبغي عدم خلطِها أو مقارنتِها بمثيلاتِها الأوروبيةِ أو بأيِّ مثالٍ آخر في أيةِ بقعةٍ من بقاعِ العالم. إذ لها موقعُها وتَمَوقعُها الخاصُّ بها. حيث أُسقِطَ دورُ هذه الشريحةِ الأرستقراطيةِ إلى مرتبةٍ أداتيةٍ تُوَظَّفُ في بسطِ تَحَكُّمِ الدولِ القوميةِ والاستغلالِ الرأسماليِّ على الكردِ وكردستان. وقد قُيِّمَ هذا التموقعُ بعنايةٍ فائقةٍ خلال القرنَين الأخيرَين كي يغدوَ أداةً أوليةً في القضاءِ على الكردايتيةِ بأساليب عدةٍ يتصدرُها العنفُ والإرغام، وتليه أساليبُ "الإبادةِ الخاصةِ والمستورةِ" التي تهدفُ إلى تخريبِ كافةِ المجالاتِ والأنسجةِ الاجتماعيةِ تدريجياً. من هنا، ومهما تمَّ التركيزُ على هذه الجوانب، فلن يفيَ بالغرضِ لدى تقييمِ ودراسةِ أصداءِ التقاليدِ الأرستقراطيةِ والطرائقيةِ وانعكاساتِها على الواقعِ الكرديِّ والحركاتِ الكردية، ولدى تحليلِ أنماطِ علاقاتِها مع العناصرِ المسيطرةِ للحداثةِ الرأسماليةِ على وجهِ التخصيص. لذا، فمن عظيمِ الأهميةِ إجراءُ بحوثٍ عميقةٍ بشأنِ أوضاعِها ومنزلتِها، وتحديدُ تداعياتِها الأيديولوجيةِ والسياسية.
ما يتوجبُ عملُه لدى التفكيرِ والإمعانِ في إرثِ الشريحةِ الفوقية، لا ينحصرُ فقط في إلصاقِ رُقَعِ الخيانةِ المعياريةِ بها، بل وينبغي استيعابُ معنى وفحوى الخصائصِ الهوياتيةِ والشخصيةِ لجميعِ الطبقاتِ والشرائحِ الاجتماعيةِ إزاءَ واقعٍ اجتماعيٍّ عُرِّضَ للإبادةِ الثقافية، وكيفَ استطاعت بسطَ تأثيرِها في سياقِ النزعةِ القوميةِ والطبقية. فالمجتمعُ الكرديُّ ليس مجتمعاً اعتيادياً حتى نقومَ بصياغةِ تحليلاتٍ عاديةٍ ومألوفة. يتشبثُ اليهودُ بعزمٍ عنيدٍ بمصطلحَي "المنفرد" و"الوحيد"، في إشارةٍ إلى الإباداتِ الجماعيةِ التي تعرضوا لها، وإصراراً على أنها إبادةٌ لا مثيل لها. وبالمقدورِ صياغةُ تعريفٍ مشابهٍ بشأنِ الإبادةِ الجماعيةِ التي تعرضَ لها الكرد. إذ جرى عيشُ إبادةٍ ثقافيةٍ "لا نظير لها" و"منفردة" و"وحيدةٍ" لا تزالُ قائمةً إلى الآن. بناءً عليه، ثمة حاجةٌ ماسةٌ إلى عملياتِ بحثٍ وتدقيقٍ خاصةٍ بها. وتقييمُها ارتباطاً بإرثِ الشريحةِ الكرديةِ الفوقيةِ وبامتداداتِها الحالية، والتي لها مكانتُها المُعَيِّنةُ في تطبيقِ الإبادةِ الثقافيةِ في هذا المضمار؛ إنما يتسمُ بأهميةٍ مصيريةٍ على صعيدِ صونِ الوجودِ الثقافيِّ الكرديِّ وتحريرِه.
- b) أسفرَ انهيارُ نظامِ الإمارةِ عن إبرازِ الهرميةِ الدينيةِ إلى المقدمة. وأفضَت هزيمةُ كلٍّ من بدرخان بيك ويزدان شير إلى اكتسابِ مؤسسةِ المَشيَخةِ مبادرتَها بعدَما تعززت تدريجياً مع حلولِ النصفِ الثاني من القرنِ التاسع عشر، وإلى تعويلِها على دورِ القيادةِ داخلَ المجتمع. وقد اكتسبَ شيوخُ النقشبنديةِ والقادريةِ أهميةً كبيرةً بوجهٍ خاص. فكِلتا الطريقتَين لهما مكانتُهما الوطيدةُ تقليدياً في كردستان. ولكن، من الضروريِّ بمكان عدم النظرِ إلى تقاليدِ المَشيخةِ على أنها مؤسسةٌ حِكرٌ على العصورِ الوسطى فقط. بل تمتدُّ جذورُها إلى دولةِ الرهبانِ السومريين. فرهبانُ الزقوراتِ السومريةِ كانوا أولَ من ابتكرَ جهازَ الدولة. أي إنّ تكوينَ الدولةِ على علاقةٍ بالحكمة. وهي ليست مجردَ جهازِ قوةٍ فظة. بل إنّ معناها مُعَيِّنٌ بدرجةٍ أكبر. فالرهبانُ – ويقابلُهم في العربيةِ الشيوخ – هم الذي أداروا دفةَ الحكمِ في الدولةِ السومريةِ مدةً زمنيةً طويلة. أما الساسةُ العلمانيون، فاستولَوا على حُكمِ الدولةِ بعدَ ذلك بردحٍ طويلٍ من الزمن. علاوةً على أنّ الصراعَ بين كِلا الفريقَين النخبويَّين حول سلطةِ الدولةِ ما فتئَ قائماً دون انقطاعٍ منذ ولادتِه بالغاً يومَنا الحاليّ.
بينما لعبَت مؤسسةُ الرَّهبنةِ دوراً أساسياً في ولادةِ الدولة، فإنّ دورَ السلالاتِ العلمانيةِ برزَ إلى الأمامِ في تأمينِ سيرورتِها وتوسيعِ نطاقِها. ويُلاحظُ حصولُ مستجداتٍ مثيلةٍ في نشوءِ مراتبِ السلطةِ لدى الكردِ الأصليين أيضاً. هذا ولَم تَغِبْ المشادّاتُ والنزاعاتُ حول السلطةِ قطعياً فيما بين الرهبانِ والسلالاتِ العلمانيةِ ضمن الكونفدرالياتِ الهوريةِ والحثيةِ والميتانيةِ والأورارتيةِ والميدية. ولَطالما تواجدَت هذه الثنائيةُ على مدارِ التاريخ، بالرغمِ من محاولاتِ بناءِ جميعةٍ تدمجُ بين كِلَيهما من خلالِ مصطلحِ الإلهِ – المَلِك. كما واستمرَّ حضورُ ثنائياتٍ مماثلةٍ ضمن الأديانِ الإبراهيميةِ أيضاً بوصفِها أدياناً توحيدية. كانت الرهبنةُ في الصفوفِ الأماميةِ ضمن جهازِ القبيلةِ الإبراهيميةِ الأولى. فموسى بذاتِ نفسِه كان نبياً، وأخوه هارون كان رئيسَ الكهنة. وما برحَت هذه القرينةُ المُعاشةُ في القبيلةِ العِبريةِ مستمرةً إلى يومِنا الراهن. هذا وكان عيسى بذاتِه حاخاماً يهودياً منخفضَ المرتبة. وبعدَ مرورِ ثلاثةِ قرونٍ بحالِها على عهدِ عيسى، جرى التعرفُ على حُكمِ حُكّامٍ ليسوا برهبان. وقد حَفِلَ تاريخُ الألفِ سنة الأخيرة في أوروبا بأحداثِ الصراعِ على السلطة، والتي دارت بين المناوئين للكنيسةِ والمناوئين للعلمانية. هذا وقد تعرَّفَ الإسلامُ باكراً جداً على السلطةِ السياسيةِ وهو في مطلعِ انطلاقتِه كدين. ولَم تَمضِ ثلاثةُ عقودٍ على تأسيسِ الدولةِ الإسلامية، حتى برزَت بوادرُ صراعٍ ضروسٍ بين أهلِ البيتِ الذين يمثلون سلالةَ الكهنة، والأمويين الذين يمثلون السلالةَ العلمانية. هكذا باتَ العِراكُ بين الدولةِ الدينيةِ والدولةِ العلمانيةِ أحدَ أهمِّ نتائجِ التاريخِ الإسلاميِّ أيضاً.
ما انعكسَ على المجتمعِ الكرديِّ وصراعِ السلطةِ فيه، هو هذه التقاليدُ التاريخيةُ المُعَمِّرة. إذ تؤدي التقاليدُ الدينيةُ دوراً كبيراً في إنشاءِ وتشاطرُ السلطةِ داخل كردستان. وبينما تفضي متانةُ التقاليدِ القَبَلِيّةِ والعشائريةِ إلى تحجيمِ التقاليدِ الدينية، فقد أسفرَت عن تحجيمِ كياناتِ الإمارةِ العلمانيةِ أيضاً بدافعٍ من نضوحِ بنيتِها بالمساواةِ والحرية. وقد قُسِّمَ النفوذُ السياسيُّ في كردستان بين هذه البنى الثلاثيةِ مدى سياقِ التاريخ. لكنّ الاشتباكاتِ والتنافراتِ لَم تَغِبْ أيضاً، في حالِ اختلالِ التوازنِ فيما بينها. هذا ولَم يَجرِ تطهيرُ النظامِ القائمِ من أيةِ مؤسسةِ نفوذٍ منها بصورةٍ تامة. وبينما سادت المنازعاتُ والمساوماتُ حول اقتسامِ السلطةِ بين صفوفِ الشرائحِ العليا، فقد برزَت تداعياتُ وامتداداتُ ذلك بين صفوفِ الشرائحِ السفليةِ أيضاً. كما وأبرزَ التشاطرُ الديمقراطيُّ للاقتدارِ حضورَه أيضاً داخلَ بنيةِ المؤسساتِ الثلاث. لذا، يستحيلُ الحديثُ هنا عن وجودِ سلطةٍ مطلقة. حيث ما انفكّت مستمرةً عملياتُ التحجيمِ التي أجرَتها التقاليدُ الديمقراطيةُ بنحوٍ وطيدٍ دون انقطاع. ولَم تستطِعْ كلُّ مؤسسةٍ الاستمرارَ بوجودِها، إلا بين صفوفِ قاعدتِها الجماهيريةِ هي، أي بين "ديموسِ"ـها. ولَطالما حوفِظَ على التوازناتِ من خلالِ "الديموس"، بالرغمِ من بروزِ إحدى المؤسساتِ إلى المقدمةِ بين الفينةِ والأخرى.
يتبع ...